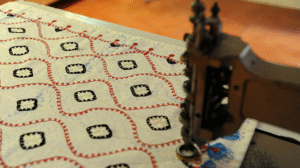منصة إرادة- عبد الكريم عمرين
المرأة أحبّت رجلاً من القوات الحكومية، كان طويلًا، ذا عينين زرقاوين، وابتسامة خفيّة لا تفارق وجهه. صحيح أنه تجاوز الخمسين من العمر، لكن السنين لم تغيّر في محيّاه ورجولته. كان مسؤولًا عن حاجز في حي البياضة، الحيّ الفقير في حمص، لكنه الملتهب والحاضن الأساسي للمتظاهرين، وللثوار فيما بعد.
كانت انتصار، حين تمر على الحاجز لإحضار السلّة الغذائية أو لشراء الخبز، ترسل له إشارات إعجاب بعينيها، مجرّد بريقٍ أنثوي ترمق به يوسف، الجالس على كرسيّ ضخم من طقم “ستيل” مسروق، يدخّن السيجار الكوبي، ويضع على عينيه نظارةً شمسيّة. هذا الغموض والجمال هو ما شدّ تلك المرأة إلى يوسف، المساعد في جيش الحكومة والمسؤول عن الحاجز.
كان يوسف يراقبها يوميًا تقريبًا وهي تمرّ، ويلاحظ أن إعجابها يشوبه فحيحٌ جنسي، وأن هذه المرأة لبوة مكتملة الأركان الأنثوية، فبدأ يهتمّ بها، يسأل عن اسمها، أحوالها، أين تسكن، من هي أسرتها؟ وحين اطمأنّ إلى أنها لا تنتمي إلى المعارضة أو حاضنيها، صار يوعز للجنود بأن تمرّ على الحاجز بسلاسة، دون أسئلة أو تفتيش.

المهم، تركت انتصار زوجها عبد اللطيف بعد خمسةٍ وعشرين عامًا من زواجها منه، وتزوّجت يوسف من القوات الحكومية. تخلّصت انتصار من زوجها عبد اللطيف، من قبحه وبلادته وبُخله، من عجزه الجنسي، ومن رائحة فمه الكريهة. وزوجها عبد اللطيف تزوّج أيضًا. طلاق في أيام معدودات، وزواج في أيام معدودات لكليهما. فما أسهل، وما أصعب، الانفصال والاتصال، العاطفي وغير العاطفي، في زمن الحرب.
انتقلت انتصار للعيش مع يوسف في بيتٍ “لا ينقصه شيء” كما يقولون. بل فيه أثاث مكرّر بنسختين، وخزنة حديد متخمة بالعملة السورية، ممهورة أوراقها بصورتين للأسدين المستبدّين: الأب ثم الابن. عفش كثير جاء به معفّشٌ صاحبُ حاجز، يُؤمر فيُطاع، ويأخذ حصته — وهي الأكبر — من المال الذي يفرضه الجنود على المشاة والبضائع، حتى لو كان المحمول علبة تبغ أو دواء.
أما عبد اللطيف، وأمام مصاعب جمّة منها قصف بيته، وانقطاع الكهرباء تمامًا، وشحّ المياه، فقد فضّل الانتقال إلى مركز نزوح صغير نسبيًا، بيت عتيق مؤلّف من طابق أرضي وطابقين، في حي راقٍ في حمص، مقابل المسبح البلدي، لا يبعد سوى أمتار عن شارع الحمراء، المشهور بمطاعمه وكافيترياته الأنيقة جدًا. سكن عبد اللطيف في غرفة واحدة في الطابق الثاني مع زوجته الجديدة، وابنته افتخار ذات الأربعة عشر ربيعًا.
أما ابنه أمجد، الذي كان يؤدي خدمته الإلزامية منذ أكثر من أربع سنوات، فلم يعرف أبدًا أن والدته انفصلت عن والده، وأن أخته افتخار صارت صبية جميلة، في صدرها كرزتان ناضجتان. كان يُجبر على محاربة القوى المناوئة للحكومة، المعارضة، التي تسلّحت وهيمنت على أجزاء من أراضي الوطن.
عبد اللطيف وزوجته الجديدة، نظمية، وقد تزوّجها بعد أن هاجر أهلها إلى لبنان وانقطعت أخبارهم تمامًا، وكان زوجها قد اعتُقل في الشارع، وغاب في أحد السجون لأشهر، ثم أخبرها رجال الاستخبارات أنه توفي في السجن بسبب أزمة قلبية، وقد تولّوا دفنه، وأعطوها هويته وشهادة وفاته.
عاش عبد اللطيف وزوجته الجديدة وابنته افتخار ينتظرون أن يأتيهم خبزهم كفاف يومهم، أو بعض اللحم من متبرّع، وينتظرون أن تتوقّف الحرب. كان عبد اللطيف يبدي انزعاجه وغضبه لأن الحرب طالت أكثر مما يجب، يدخّن بشراهة، ويشرب الشاي بنزق، ويضرب على رجله بباطن كفّه وهو ينظر إلى السماء من خلال النافذة الزرقاء صارخًا:
يا رب، لأيمتى يعني؟
ليس اعتراضًا على حكمك ومشيئتك، أعوذ بالله، لكن افرجها علينا، أرجوك.
ثم يغبّ ما تبقى من كأسه، ويدعك بقايا سيجارته في صحنٍ معدني صدئ الأطراف.
لكن عبد اللطيف، في سرّه، كان مبسوطًا، ويتمنى استمرار الحرب. فهو يأكل ويشرب وينام مجانًا، في حي راقٍ، بعيد عن الحرب والقذائف و”الشيلكا” الملعونة.
حتى جاءه الخبر المفجع…
على باب مركز النزوح في حي الحمراء الراقي بحمص، بقي عبد اللطيف، ولثلاثة أيام متوالية، ينتظر على الرصيف جثمان ابنه أمجد ليودّعه إلى مثواه الأخير. أمجد، المقتول في حقل شاعر شرق المدينة، على يد قوات المعارضة.
سيارة الإسعاف الهرمة، المدروزة بالرصاص، حملت جثمان أمجد. والجثمان لم يكن أكثر من تابوت منخور، ملفوف بعلم الوطن المتسخ والممزق. بكى عبد اللطيف ولده، مرّغ وجهه بعلم الوطن، وترك فوقه دموعه ومخاطه ونشيجه. أراد أن يُلقي نظرة الوداع الأخيرة على فلذة كبده، وأن يمنحه القبلة الأخيرة، لكن الجنود بوجوههم الشمعيّة منعوه.

بجانب التابوت جلست أم أمجد، ساهمة، جامدة، متجهمة. حضرت ابنتها افتخار بثوبٍ مجعوك ومرقّع، وبشحّاطة ممزّقة بلون فوسفوري. حارت افتخار: ماذا تفعل؟
هل تضم علم الوطن؟ أم تضمّ أمّها، التي تركتها وذهبت إلى حضن رجل آخر؟
هل تبكي أخاها المقتول؟ أم تبكي حضنًا وأمانًا افتقدته؟
هُرعت زوجة عبد اللطيف الجديدة، سحبت افتخار من حضن أمّها بغضب.
الزوجتان، السابقة واللاحقة، مارستا وتبادلتا الكيد وأقذع الشتم، شدّ الشعر، والضرب بالأحذية.
وكلّ منهما تمسك بإحدى يدي افتخار، وتشدّها إليها.
هرج ومرج، افتخار حائرة وباكية، دون شحّاطتها الفوسفورية. وعبد اللطيف عاجز ومبهوت.
ضحك الجنود باقتضاب، تفرّسوا في مؤخرات “بطلات المصارعة النسائية”، ثم أخذوا الجثة ورحلوا إلى مكانٍ مجهول، بعد أن رموا لعبد اللطيف أسمال ابنه أمجد، وهويته المدنية، وشهادة “شهيد”.
بقيت افتخار، التي أزهر كرزها حديثًا جدًا، ممزّقة في دائرة الطباشير غير القوقازية، تتجاذبها بقسوة أمّها وضرتها، ترمقها نظرات مكسورة من أبيها البليد، وفي جيب ثوبها ماتت أزهار الياسمين، وزهورٌ كانت تريد أن تهديها لأخيها القتيل… أو الشهيد.
إنها دائرة الطباشير السورية.

مسرحية برتولد بريخت، دائرة الطباشير القوقازية، تحكي عن ملكه تتخلى عن طفلها الرضيع وتهرب مع زوجها خوفًا عند انهيار حكمهما، ويظل الصغير في رعاية الخادمه حتى تمر الأعوام وتعود الملكة للحكم وتطالب بأسترداد إبنها لكن الخادمه تتمسك به وعندما يقع القاضي في حيرة من أمره يرسم دائرة بالطباشير، ويضع الطفل فيها، ويطلب من كلا الملكة والخادمة جذبه، ومَنْ تتمكن من إخراجه من الدائرة تظفر به. تشده الملكة بعنف، بينما ترفض الخادمة أن تشده حتى لا تؤذيه. تفوز الملكة لكن القاضي يقرر أن يعطيه للخادمة التي ربته، وليس للأم التي لم تأبه للألم الذي يمكن أن تسببه له إذا شدته بقوة.
يرى البعض أن فكرة بريخت من وراء هذه المسرحية “إذا أحببت شيئاً فلا تتنازع عليه وتمزقه”. ويرى آخرون أنه يدافع عن فكرة أن “الأحق بالشيء هو من يحافظ عليه ولا يؤذيه”.