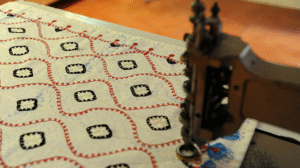وسيم كناكرية
في يوم الأحد الماضي، كان عبد الرحمن البلدي، أستاذ الدراسات الاجتماعية في مدرسة “بسمة أمل للمكفوفين”، يمشي في ساحة العباسيين التي كانت تعج بالحياة، فذلك اليوم كان يوم عيد الفصح. استأنس عبد الرحمن بأصوات المارة، مثل أي كفيف يرغب في سماع الأصوات المصاحبة لوقع عصاه البيضاء على الطريق. وكحدث روتيني، اصطدمت عصا عبد الرحمن بشخص، فاعتذر كعادته، وأكمل طريقه. كان متجهًا إلى موقف السرافيس ليعود إلى منزله في ريف دمشق.

مرت بضع دقائق، ثم لم يشعر عبد الرحمن سوى بشخص يقترب منه ويسأله: “ما الذي يوجد في هذه الحقيبة؟”، فأجابه عبد الرحمن بتلقائية: “لابتوب”. ثم لم يشعر إلا بيد الشخص تمتد لفتح الحقيبة المعلقة على كتفه. وكردّ فعل طبيعي، تراجع عبد إلى الوراء وأبعد يد الشخص الذي أصرّ على موقفه واقترب أكثر محاولًا انتزاع الحقيبة بخشونة. صرخ عبد: “ما شأنك؟ ولماذا تحاول أخذ الحقيبة مني؟”، ليرد عليه الصوت بأنه “عنصر من عناصر الأمن العام”.
قال عبد: “وما الذي يؤكد لي أنك لست لصًا تنتحل صفة الأمن العام؟”، فبادره الشخص بشدّ الحقيبة أكثر. فما كان من عبد الرحمن إلا أن قال: “يا أخي، قلت لك يوجد بها جهاز الحاسوب المحمول الخاص بي، وإن كنت صادقًا وأنت من الأمن العام، فخذني إلى المسؤول المباشر عنك، لكي أضمن حقي وأتأكد من هويتك”.
فأجابه الشخص: “كما تريد، سآخذك إلى المسؤول المباشر وسأخبره بأنك تتظاهر بالعمى لكي تتحرش بالفتيات المارات”.
لم يكن من عبد سوى أن ضحك وقال: “أتظاهر بالعمى وأتحرش بالفتيات؟! كيف لي أن أتحرش بالفتيات، إذا كنت أنت الذي تحدثني لم أعرف أنك شاب إلا عندما خاطبتني؟! وبكل حال، لا مشكلة لدي، هيا خذني إلى المسؤول عنك”.
أمسك عبد بيد الشخص كي لا يتيه عنه، ليتفاجأ بأن ذلك الشخص يشد على يده ويجره خلفه.
قال له عبد: “لماذا تجرني هكذا وأنا من طلب الذهاب معك للمسؤول؟! لم أبدِ مقاومة”.
ولكن دون فائدة، استمر الشخص في تعامله الفظ مع عبد، الذي لم يسكت، وأعاد السؤال مرارًا: “لماذا تعاملني بهذه الطريقة؟”، ليُصدم بذات الكائن يلتفت إليه ويصفعه على وجهه صفعة أعادت إلى ذاكرته مشاهد النظام البائد من تشبيح وتخويف وانتهاكات. صفعة لم ينقصها سوى عبارة: “أنت بتعرف مع مين عم تحكي؟”
أصر عبد الرحمن على الذهاب لمخفر الشرطة وتقديم شكوى فيما حاول زملاء الشاب الذين حضروا بعد أن قام الشاب باستدعائهم “لفلفة القصة” مع تهديد مبطن، تارةً بالتهدئة “ازرعها بدقنا” وتارةً بالتبرير “الشاب من اللجان ومتوترين بالعيد”، وتارة بالتعهد له بأنهم سيحاسبوا الشاب بوقت لاحق تماما كما طلب منهم عبد الرحمن.
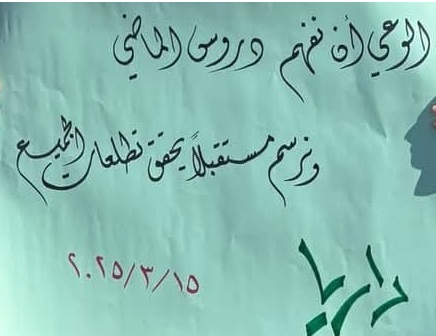
انتهت القصة عند “الشباب”، “اللجان”، و”الأمن العام”، أياً كان اسمهم وغالبا ناموا مطمئنين كما في كل ليلة. أما عبد الرحمن فقد ضاق الليل على كوابيسه، وأعاد شريط حياته يمر أمامه، ذاك الذي طالما افتخر به بين أقرانه. كيف لا، وهو الذي تفوّق في دراسته طيلة حياته في المعهد الخاص بالمكفوفين، وكان الأول على قسم التاريخ في جامعة دمشق لأربع سنوات متتالية، وهو الأستاذ المحبوب بين طلابه. أما الآن، فهو الكفيف الذي تلقى صفعة من شخص ربما لم يدخل المدرسة. كان المشهد يُعاد ويُكرر، فيما صدره يضيق كأن جرحاً قديماً قد انفتح.
عندما أخبرنا عبد الرحمن بالقصة، صمتنا جميعاً. ليس لأننا نسمعها للمرة الأولى. بل لأنها طالما تكررت في الماضي الذي اعتقدنا أنه ذهب إلى غير رجعة.
تشير كثير من تقارير الأمم المتحدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للعنف أكثر من غيرهم بمعدل الضعف، وترتفع هذه النسبة لثلاثة أضعاف في الدول التي تعيش حالة حرب أو التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية. كانت قصة عبد الرحمن، تذكرة لنا جميعاً أننا لم نخرج بعد من دائرة العنف وأننا ما زلنا ضحايا منسيين، لا يتم احتساب كوابيسنا.
في الواقع، يرى علماء الاجتماع بأن وجود إعاقة سيجعلك تلقائيًا هدفًا لبعض أشكال الإساءة، وأن المزاج البشري يستسهل العنف ضد الضعفاء، سواء كانوا أطفالاً، نساءً أو ذوي إعاقة. وفي حين لا أستطيع فهم التعقيد النفسي الذي يجعل إنساناً ما عنيفاً تجاه إنسان آخر، فقط لأنه أضعف منه، فإنني أعرف بشكل مطلق أن منع ذلك لا يتم إلا بتطبيق القانون. لكن ماذا إذا كان من سيطبق القانون هو من قام بهذه الإساءة؟
قال أحدهم “كلو كف”، لكن هذا الكف نفسه هو من ضرب سوريا على مدار عقود. صفعة من يملك السلطة والسلاح والأمن، بوجه الضعيف، المجرد من إنسانيته، والذي عليه أن يصبح أعمى وأطرش وأخرس أمام سطوة التشبيح، وتهديد المخابرات وسلطة السلاح. حتى لو كانت فقط سلطة عنصر من اللجان على ساحة لا تتجاوز كيلو مترا واحداً.