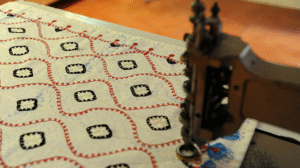وسيم كناكرية
استيقظنا على نداءات لإخلاء البيوت، فالمعركة ستشتد وسيحمى الوطيس أكثر، المكان حي الميدان في دمشق، التاريخ 21/07/2012، فتحت عينيّ بشكل روتيني لا معنى له، فأنا من ذوي الإعاقة البصرية، نهضت متلمسا حاجياتي وجدران غرفتي مودعاً فربما لن تكتب لي العودة، أو ربما لن يكتب لهذه الجدران البقاء.
خرجنا من البيت، أهلي وإخوتي وأنا. التزمنا المشي جوار الجدار، أصبح لجملة “مشينا الحيط الحيط” التي حاولنا الالتزام بها كل عمرنا معنى أشد إيلاماً. رائحة الموت كانت في كل مكان. سيطر عليّ شعور بالاستسلام التام للعتمة.

في يوم هروبنا من حي الميدان بسبب الاشتباكات، حسدني الناس على نعمة فقدان البصر، فيومها لم أر معالم الطريق التي كانت مليئة بالدمار والجثث، الرصاص يهطل من كل مكان، وكل ما أستطيع تمييزه هو أنفاس اسرتي الخائفة، والدموع المكتومة، وصوت الماء المنهمر من الخزانات المثقوبة، ومظاريف الرصاص التي تبعثرت على الطريق. في تلك اللحظة، كنت محظوظاً لأني لم أر تلك المشاهد التي شهق أهلي لحظة رؤيتها، وبنفس الوقت لم أتجرأ على سؤالهم ما رأوا في لحظة الهروب تلك.
كنت قد اعتقدت أني نسيت هذا اليوم، لكن الذكريات تفجرت من جديد. هذه المرة، تذكرت المشاهد التي لم أرها. على مدى سنوات، كان يجري إعادة سرد تلك اللحظة، ليتسرب تفصيل جديد في كل مرة، جثة هنا وولد ضائع هناك وجار يحمل زوجته.
ذكرى كهذه والعديد من أمثالها كانت مدفونة في أعماقي، ولم أكن أجرؤ أن أوجهها، ولكن ما يحدث اليوم أعادها لتفرض نفسها بثقلها على كل تفكيري، طارحة أسئلة من الصعب أن أجد أجوبة لها دون المرور على تلك الذكريات التي طالما حاولت دفنها، ذكريات محفوظة على شكل صوت ورائحة. بلا ألوان.
التاريخ 7/12/2024. المكان حي الميدان، ذات المنزل وذات الجدران، ولكن زاد في المشهد وفي حياتي شخصان جديدان زوجتي وابني، الخوف أكثر أن تعاد الكرة، هل سأستطيع حمل ابني والهروب؟ هل إن خرجت سأستطيع الركض إلى بر الأمان أم سأركض إلى حضن الخطر، تذكرت التسجيل المصور الذي استمعت إليه لمجزرة حي التضامن، لا أستطيع وصف مشاعري حينها، هل كانت الغضب؟ هل كانت الرعب؟ هل كانت عدم التصديق؟ أم كانت مليارات المشاعر المختلطة، حينها حمدت ربي على نعمة فقدان البصر لكيلا أرى هذه الفظائع، لكن للأسف التسجيل كان صوتاً وصورة، مما جعلني أستمع، أستمع لأشخاص يقتلون بدم بارد وهم معصوبو الأعين، لا يرون، وضعت نفسي مكانهم، أركض متبعا توجيهات الجزار الذي بالنسبة لي هو الدليل، لأسقط في حفرة مليئة بالجثث مقتولا برصاصة ثمنها قصة حياتي منذ أن ولدت حتى اللحظة التي قرر فيها قاتلي أن يضغط على الزناد، تذكرت صوت وقوع أجسادهم في الحفرة، تذكرت صوت قاتلهم، وزملاؤه يمزحون بدم بارد، وكأن شيئاً لم يكن.
بقيت على هذه الحال هكذا حتى الصباح، صباح يوم الأحد 8/12/2024 عندما هدأت الأمور، و (لا أصدق أني أكتب هذه العبارة للنشر) و… و… وسقط النظام…
عانقت زوجتي وابني ومن كل قلبي تمنيت ألا تعود تلك الأيام، تمنيت ودعوت لله أن ننسى ركام 14 عاماً من الآثار النفسية السلبية التي عشناها، دعوت أن يكون المستقبل مشرقاً، كفرحة الناس، تذكرت كيف كنت ذات مرة في الشارع أمشي بالعصا البيضاء الخاصة بي وإذ بمظاهرة تبدأ ليبدأ معها إطلاق النار، ركضت لأنجو بنفسي مدفوعا بغريزة البقاء، ولكن إلى أين؟ لا أعلم، فقد فقدت إحساسي بالاتجاه. أسمع أزيز الرصاص ولا أعلم إن كنت أركض باتجاهه أم بعيداً عنه، لا أدري كم مرّ من الوقت قبل أن تمسكني يد لتركض معي. لم أسأل عن هوية ذاك الشخص الذي أنقذني، يومها كل همي كان النجاة، لم أتحدث معه أو معها كنا فقط نركض، حتى وصلنا إلى لحظة الأمان، لكنها لم تكن أكثر من لحظة، فالأمان اختفى والخطر والخوف أصبحا جزءاً من الأمس. كنا نعرف أن بعضنا أموات مدفونون وبعضنا أموات يمشون.
أتذكر هذه اليد اليوم، وأتمنى أن أعرفها وأشكرها. أتذكرها وأنا أرى أيادي مثلها تفتح سجوناً ومعتقلات. أسمع أصوات معتقلين سلبوا الضوء، وحبسوا في العتمة والأقبية والظلام، ليفقدوا نعمة البصر وهم يملكونها، ولكنهم أيضاً كانوا قادرين على سماع أصوات صراخ زملائهم، أو ضحكات وشتائم معذبيهم. يشمون رائحة العفن، يشعرون بالبرد، لتأتي تلك اليد مكسرة أقفال زنازينهم مصطحبة إياهم إلى بر الأمان، لم أر تعبيرات وجوههم، ولكن شعرت بسعادتهم، فلا سعادة أكبر من أن تكون بظلمة محاطاً بالخطر وتأتي يد دافئة وحقيقية وقوية، لتصحبك إلى النور. نور الحرية الذي يراه، حتى، ذوو الإعاقة البصرية.