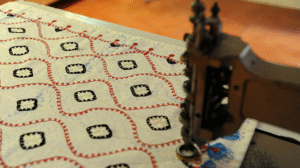مياس سلمان
برفقة صديق الطفولة الذي اعتدنا منذ الصغر أن نعيش الأجواء الحماسية التي ترافق مباريات كرة القدم، توجهتُ إلى المقهى لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني. كنا قد قضينا الأيام الماضية في التخطيط لهذا الحدث، ربما لعشقنا للساحرة المستديرة، وربما للهروب من ضغوط الحياة المختلفة، هو يريد الهروب لساعات من هموم ومسؤوليات أسرته وحسابِ كم يحتاجُ ثمنَ حليبٍ وحفاضات لابنه الصغير، وأنا أريد أن أنسى أني تجاوزت الخامسة والثلاثين وفشلت بتحقيق حلم تكوين عائلة. هناك في هذا المقهى لا أحد ينظر لي، أشعر فجأة أني أشبه الآخرين كثيراً، جميعنا ننتظر بشغف بداية المباراة، ونعلق على تلك الكرة كثيراً من أحلامنا المكسورة.

فالرياضة عامة وكرة القدم خاصة قادرة على توحيد الناس أكثر من أي شيء آخر. كلنا عشنا فرحة الشعب العراقي بعد الفوز والتتويج بكأس أسيا عام (2007). بلد كانت قد أوجعته الحرب ودمرته، ووحده منتخب وطنه ليعود ويشعر بلحظة ولو مختطفة بالفخر الوطني. أذكر كم ذرفت دموع فرح حينها، وأعي أن جزءاً كبيراً من حماسي هذه الأيام وأني أتمنى ذرف مثل هذه الدموع واختطاف مثل تلك اللحظة.
هذه الكرة لها مفعول السحر حتى في أشد الأوقات، ففي عام 1969، اتفق فصيلان متقاتلان في نيجيريا على هدنة مؤقتة كي يتسنى للجميع مشاهدة مهارة بيليه الكروية الذي جاء ليلعب مع فريقه سانتوس. وقبل سنوات قليلة وتحديداً في 2005، طلب “يدييه دروجبا”، أسطورة تشيلسي الإنجليزي، من أطراف الصراع المسلح في بلده ساحل العاج “أن يتعايشوا في سبيل هدف مشترك ألا وهو التأهل لكأس العالم”، وأمام صدمة العالم، تم إطلاق اتفاق لوقف إطلاق النار بعد عدة أسابيع.
كانت أول مباراة للمنتخب السوري مع فريق أوزباكستان، وهو أفضل منا في التصنيف الدولي. كان موعد المباراة الساعة الثامنة والنصف. وفي ظل انقطاع الكهرباء خمس ساعات مقابل رجوعها لساعة واحدة فقط أي (5-1) لصالح وزارة الكهرباء، كان يستحيل مشاهدتها في المنزل، كما أن القنوات الناقلة مشفرة والأزمة الاقتصادية الخانقة تجعل من شبه المستحيل أن يدفع المواطن رسم اشتراك، ليبقى الخيار إما مشاهدة المباراة عبر الإنترنت على الهاتف أو في أحد المقاهي.
قررتُ مشاهدة المباراة في المقهى برفقة صديقي وبما أننا في قرية نائية اتفقنا أن تكون العزيمة على حسابي مقابل أن يتحمل هو مصاريف البنزين لدراجته النارية. فالمقهى يبعد عنا حوالي سبعة كيلو مترات.
وصلنا المقهى الصغير الذي لا يتسع لأكثر من أربعين شخصاً، فيه ثلاث شاشات كبيرة. أول ما لفت انتباهي قدوم رجل كبير في السن تجاوز الخامسة والستين من العمر لا توجد في رأسه شعرة سوداء ويرتدي نظارة طبية برفقة ولد لا يتجاوز السبع سنوات بدأ بالقفز حماساً قبل أن يبدأ اللاعبون بالجري في الملعب. كانت الأجواء حماسية والأعصاب مشدودة، توتر وقلق حتى اللحظة الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي ليحصل كل فريق على نقطة.
أخذ الجميع، محللون ونقاد على الشاشة وأنا وصديقي وبقية رواد المقهى والطفل ذو السابعة نُشيد ببراعة الدفاع السوري ومهارة حارس المرمى. توصلنا إلى أن المنتخب هذه المرة كان منظماً ويلعب بروح جماعية بعكس المنتخب السابق الذي كان يغلب عليه العشوائية واللعب الفردي، كانت هذه الاستنتاجات كفيلة بأن تمنحنا دفقات من الأدرينالين والحماس الذي يقارب اليقين بأن القادم للمنتخب أفضل. ترقب متفائل جعل انقطاعات الكهرباء والأسعار المجنونة وتقلبات الطقس والأخبار السياسية تبدو أقل وطأة وأقل قسوة من عادتها.
كنت قد قرأت منشوراً لرفيف مهنا، وهو طبيب نفسي سوري يقيم في فرنسا بشرح فيه أهمية مشاهدة منتخب سورية ويعترف أنه يغلق العيادة وقت المباراة لأن نتيجة المباراة تؤثر على نفسيته إيجاباً أو سلباً حسب النتيجة فوزاً أو خسارة. وهكذا توصلت إلى قناعة أني لم أحضر مباراة فقط، بل خضعت لجلسة علاجية أزالت بعض الآلام النفسية وربما الجسدية أيضاً. كم نحتاج ـ نحن الشعبَ السوري المتعب ـ لمثل هذه الجلسات…
تراجعت كرة القدم المحلية في سورية بعد الحرب تراجعاً كبيراً. البنية التحتية والملاعب مهملة وبعضها مدمرٌ بالكامل كاستاد حلب الدولي الذي كان من أفضل الملاعب في الشرق الأوسط. بعض الملاعب مهجورة ولا تصلح حتى لرعي الأغنام كما أنها تتحول في الشتاء إلى برك مياه ومستنقعات وحل، فيما فرق الدوري فقيرة تنتظر ميزانياتها المضحكة من الحكومة بالتقسيط.
منذ أيام فقط، اعتذر نادي الحرية الحلبي عن مباراة في الدوري السوري مع فريق الوحدة الدمشقي بسبب عدم قدرته على تأمين أجور المواصلات. عندما عرفت هذا الخبر، تذكرت كيف تعاقد كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي العام الماضي براتب مئتي مليون دولار. لا أستطيع تصور الرقم، لكني أعتقد أنه قد يكفي لبناء جميع الأبنية التي هدمها الزلزال في سورية. أتخيل رونالدو يعيش في قصره الخاص وطيارته الخاصة مع صديقته جورجينا وأولاده الأربعة في المملكة السعودية التي تتغاضى عن فكرة أن يعيش رجل وامرأة دون زواج، فقط من أجل قدم رونالدو الذهبية أو من أجل تحقيق انتصار ما، حتى لو كان بكرة القدم، حتى لو كان بقدم برتغالية.
لكن يبدو أن لكرة القدم في القرن الحادي والعشرين قوانينها الخاصة، فأغلب لاعبي منتخبنا محترفون في دوريات أجنبية، بل إن غالبيتهم لا يتكلمون اللغة العربية. بدا ذلك واضحاً عند عزف النشيد الوطني، ثلاثةُ لاعبين يؤدون النشيد بصوت قوي وثمانيةُ لاعبين صامتون.

مباراة منتخبنا مع الهند انتهت أول أمس. بدأت تمام الساعة الثانية والنصف، أي بعد انصراف طلاب المدارس وقبل انتهاء الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية التي تخلو عادة من موظفيها في الساعة الواحدة بسبب ضعف الرواتب التي تجبر الجميع تقريباً أن يعمل في وظيفة ثانية وثالثة ليعيش. نظرت من شباك المقهى، كان الجو غائماً ماطراً في الخارج، تذكرت كيف رأيت في الصباح عاملي نظافة في الشارع يرتدون بدلاتهم المطرية ويعملون تحت المطر الغزير لأجل راتب شهري لا يكفي ثمن اثنين كيلو من لحم العجل. تساءلت هل يهتم هؤلاء بهكذا مباراة؟ هل تتاح لهم لحظات رفاهية كهذه؟ عدتُ للنظر في شاشة المقهى أنتظر بدء المباراة. كانت الكاميرا ترصد مشجعتين للمنتخب السوري تتأهبان لدخول الملعب، واحدة ترسم علماً على خدها والثانية تحمل علماً كبيراً تلفه حول كتفيها. هما بالتأكيد ناجيتان من وطن لا يصلح للحياة. ربما تملكان رفاهية الغربة للشعور بالانتماء للمنتخب الذي يمثل بلدهم أكثر من عاملي النظافة.
كانت المباراة حارقة للأعصاب حتى أخر اللحظات. شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بعد أن أضاع منتخبنا فيه العديد من الفرص السانحة للتسجيل، ليتسلل القلق والخوف في نفوس الجميع. أجرى المدرب في الشوط الثاني عدداً من التبديلات الهجومية ومضت نصف ساعة دون أن تتغير النتيجة حتى نجح مهاجم سورية النجم عمر خريبين الذي دخل بديلاً بتسجيل هدف الفوز لتملأ المقهى تلك الأصوات المقهورة التي بحت وهي تهتف غول… سورية سورية سورية… حتى نهاية المباراة.
انتهت المباراة، ربما بقيت الفرحة تغلي فينا بضع ساعات قبل أن نعود بعدها للواقع حيث الأزمة الاقتصادية الخانقة وغلاء المحروقات والدواء وقلة فرص العمل. وقف صديقي عند بائع الخضار، أمسك ثلاثة قرون موز ووضعها على الميزان. كان ثمنها ثلاثة عشر ألفاً، اشتراها لأجل طفله ذي السبعة أشهر ليأكل نصف موزة يومياً، فهي تبقى أرخص من حليب الأطفال. تذكرت قبل سنوات قليلة كيف كنا نقف أمام بائع الشاورما ونأكل حتى التخمة ثم نختلف من منا يريد دفع الحساب. اليوم لم يملك جرأة أن يسألني إن كنت أريد تناول قرن موز؟
ركبنا دراجته النارية كان البرد لاسعاً، ولكن نشوة الفوز وحرارة الحماس جعلنا لا نشعر بالبرد فعلى الأقل كنا نشعر بسعادة إضافية بسبب توقف المطر وأننا سنصل المنزل دون أن نغرق. كان ذلك الإنجاز لا يقل عن إنجاز الفوز في المباراة. كم نحن شعب جبار حقاً؟ ما زلنا قادرين أن نجد متسعاً للفرح وللشعور بالانتماء والأمل وإمكانية الحياة تحت الشمس وليس في ظل الأزمات المتلاحقة التي لم تبقِ فينا إلا بقايا للأحلام.