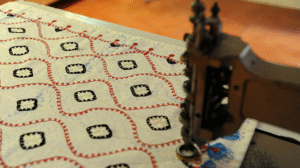شيماء شريف
كنت قادماً من الكويت برفقة زوجتي وأطفالي: أحمد 5 سنوات، وهبة 4، وأغيد عام ونصف، لحضور حفل زفاف أخي عام 1983 في قريتي (سعلو) شرق مدينة دير الزور. كان يوم ثلاثاء وكنت أريد أن أزف العروسين بسيارتي الخاصة التي أتباهى بها. وبعد أن اجتزت الحدود السورية حوالي الثانية صباحاً، رأيت ضوءاً قوياً، وسمعت ضجيجاً مرعباً، ممزوجاً بصراخ زوجتي، ثم غبت عن الوعي إلى أن استيقظت في اليوم التالي في إحدى مستشفيات دمشق. حكمة الله اقتضت أن أبقى على قيد الحياة، ولكنني لم أعد بعد الحادثة نفس الشخص… لم أعد ذلك الشاب الجامعي الوسيم الذي يعمل في الخليج ويعود كل صيف إلى قريته ليستمتع بالإجازة الصيفية برفقة العائلة والأصدقاء، ثم يعود ثانية إلى عمله.
يروي لي العم أبو أحمد “شاكر أحمد- 75 عاماً” قصته التي يمكن أن تقرأ فصولها على جسده النحيل جداً وعينيه الغائرتين، وعلى ساقين تبدو إحداهما كغصن شجرةٍ يابس. هذا الغصن الذي فقد قدرته على تحريكه منذ وقتٍ طويل.

يبتسم ابتسامةً ساخرة. يستأنف حديثه قائلاً لي: بكل بساطة لقد ودعت ذلك الشاب الذي كنته يوماً إلى الأبد، وأصبحت العم أبا أحمد، العاجز المعوق، في نظر نفسي قبل نظرة المجتمع. بدأت رحلة العلاج التي استمرت سبع سنوات حيث احتجت إلى وضع جبيرة جبصينية التهمت ثلثي جسدي طوال أربع سنوات وأصبحت طريح الفراش، وسعيت مع زوجتي بحثاً عن العلاج في مختلف المدن السورية، وجاء خيط الأمل عندما اقترح أحد أطباء دمشق أن يصحبني معه إلى روسيا لأتلقى علاجي تحت إشراف طبيب شهير في علاج حالات تفتت العظام المستعصية، ولكن للأسف لم توافق الجهات المعنية على إرسالي للعلاج. وبعد أن فقدت هذا الحلم الذي كان بمثابة طوق النجاة الوحيد، اتجهنا إلى تجربة الخلطات الشعبية والطب البديل فبدأ وضعي الصحي بالتدهور.
حاولت أن أبحث عن عمل بعد أن استقرت حالتي الصحية، ولكنها كانت مهمة صعبة خصوصاً بعد أن فقدت السيطرة على ساقي اليسرى، وفقدت جزءاً من العظم بحيث أصبحت شديدة التقوس وأقصر بكثير من الساق اليمنى. كما أن فتره علاجي الطويلة أفقدتني عادة الاختلاط بالبشر، والعكس صحيح. أذكر أنني عندما خرجت من المنزل لأول مرة، بدأ أولاد الجيران يقلدون مشيتي ويطلقون علي بعض الأسماء، التي كانت في الحقيقة مضحكة قليلاً مثل (حصان إبليس).
بعد كل ذلك، تعبت من المقاومة، وأرخيت يدي ورجلي للتيار، حتى رجلي المتيبسة تلك أرخيتها. هذه المرة طلبت من زوجتي أن تقوم بحزم كل “بناطيل الشارلستون” الأنيقة في درج الملابس القديمة، وأن تأتيني بـ”كلابية المنزل”. كنت أعتقد أن الكلابية ستخفي إعاقتي، وطوال كل تلك السنين كنت أختبئ فيها من كل شيء، من مدارس الأولاد التي لم أكن أذهب إليها كي لا أحرج أطفالي، ومن العيادات والمستشفيات عندما كانوا يمرضون، ومن سوق الخضار ومن أي مناسبة اجتماعية. أما بالنسبة للعمل، فقد قمت بفتح إحدى غرف منزلي كمحل للبقالة، وكنت أقضي فيه أكثر من ثلثي اليوم. لاحقاً، بعد أن كبر الأولاد ودخلوا الجامعات، لم يكن يعجبهم عملي ومظهري. كانت ابنتي هي الوحيدة التي تخفي هذا في قلبها وتحاول أن تظهر لي أنها فخورة بي وأنها لا تشعر بأي حرج من إعاقتي. أما ابني أحمد فلم يخف خجله بي، وكان يتجنب دعوة أصدقائه للبيت، حتى أنه استغل فرصة سفري إلى حلب لجلب بعض الأغراض وقام بهدم الدكان. وعند عودتي شعرت بصدمة كبيرة عندما رأيت مصدر رزقي وملجئي الوحيد قد سوي بالأرض، فقررت أن التزم الصمت وأنعزل تماماً عن كل الناس، حتى عن عائلتي، وصممت على هذا القرار إلى أن بدأت الحرب في سورية حيث اضطررت إلى النزوح ونسيت قراري ودكاني وساقي وإعاقتي أيضاً.

اليوم لا أشعر بالحزن على ساقي وعلى إعاقتي، بل على عمرٍ، وزمنٍ، وأرضٍ، ووطن.. أصبحت أشعر بالندم على الحياة التي لم أعشها، وعلى اللحظات السعيدة التي كان من الممكن أن أنعم بها، وبدلاً من ذلك كنت أختبئ منها غير مدرك أن الوجع القادم أكبر بما لا يقاس.
فقد بدأت شدة الاشتباكات في دير الزور بالتزايد وبدأ الأهالي بالنزوح، واقترحت على عائلتي أن تنزح بدوني، على أن أبقى في البيت لحراسته من السرقة. بصراحة، لم أكن أرغب في البقاء للسبب الذي ذكرته لهم، بل لأنني لم أعتد مرافقة عائلتي، ولم أجرؤ على القيام بهذه الخطوة لأنني كنت مسكوناً بالخوف من كل ما هو جديد. ولكن بعد خلو الحي من الجيران ومع بدء القصف، أصبحت رائحة الموت والخوف في كل مكان، فلحقت بعائلتي بعد أسبوعٍ واحد معتقداً أن عودتنا قريبة، ولكنها طالت وسئمنا من أنفسنا قبل أن يسأم منا أقرباؤنا الذين كنا بضيافتهم، فاضطررنا إلى النزوح للمرة الثانية وهذه المرة كانت إلى مدينة الحسكة ثم لحقتنا بعد أشهر قليلة الحرب مرة ثانية، واضطررنا للنزوح إلى ريف القامشلي ومن ثم إلى ريف دير الزور وعدنا إلى الحسكة ثانية بعد أن سيطرت عليها الإدارة الذاتية ولأن مدينتنا دير الزور كانت تحت حصار تنظيم الدولة ولم يكن لأحد أن يدخل إليها أو يخرج منها، إلى أن نزحنا مجدداً إلى ريف دير الزور الشرقي، بالتحديد قرية الكسرة. ولن أستغرب أن أكون قد نسيت أحد نزوحاتنا التي أصبحت جزءاً عادياِ من يومياتنا. وأخيراً عدنا إلى دير الزور مدينتنا الأولى، ولكن لم نعد إلى بيتنا لأن الحي كان مدمراً بالكامل فاستأجرنا منزلاً بسيطاً، آملين بألا نجبر على النزوح مرات أخرى.
وخلال هذه الرحلة، أصبح لدي لقب جديد وهو العم أبو أحمد النازح المعوق. كان لدي هدف واحد هو تهريب أولادي خارج البلد، حفاظاً على سلامتهم، ولأنني كنت أريدهم دائما ألا ينخرطوا في هذه الحرب، ولا بأي شكل من الأشكال.

اليوم، أشعر وكأنني أرض وليس إنسان، لم يعد بإمكاني الحركة إلا بمساعدة زوجتي والتي لم تعد بصحة جيدة أيضاً. لقد عدنا اثنين كما بدأنا اثنين في أول زواجنا، ولكن عجوزين نعرج بكسل ونمضي ما بقي لنا في من أيام بعد هجرة الأبناء إلى ألمانيا وزواج ابنتنا الوحيدة، وبعد أن استنزفت رحلات النزوح الصعبة أملنا وما تبقى لنا من صحة وعزيمة.
اليوم، بعد أن عشت سنوات الحرب، ورأيت ما رأيت من اشتباكات ونزوح وشهداء وحصار وجوع وقتل وتهجير وإصابات وإعاقات، شعرت بأن ماكنت أعتقده مأساة حياة وانكسار، وأقصد هنا إعاقتي القديمة، لا يساوي شيئاً ولا يستحق كل ذلك الاختباء الذي اختبأته، واليأس الذي اختبرته. اليوم لا أشعر بالحزن على ساقي وعلى إعاقتي، بل على عمرٍ، وزمنٍ، وأرضٍ، ووطن.. أصبحت أشعر بالندم على الحياة التي لم أعشها، وعلى اللحظات السعيدة التي كان من الممكن أن أنعم بها، وبدلاً من ذلك كنت أختبئ منها غير مدرك أن الوجع القادم أكبر بما لا يقاس.