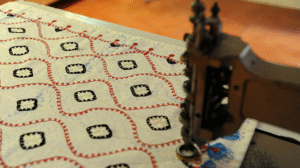في قريتي الصغيرة، تربينا أن نتعاطف ونظهر تعاطفنا مع من يملك نوعاً من أنواع الإعاقة. كان هذا تقريباً كل علاقتي بهم. علاقة عن بعد، إن اقتربت، فعليّ أن أظهر حسن تربيتي وأخلاقي الحميدة بأن أكون حنوناً ودوداً، وأن أقدم أي مساعدة ممكنة، خاصة المادية التي يحتاجونها بالتأكيد. علاقة كنت أفضل أن تبقى بعيدة وسريعة، أؤدي خلالها واجبي الذي يجلب لي بعض الرضى النفسي. أعلم اليوم أن هذه المقاربة التي أكاد أجزم أن الأكثرية تتبناها سلاح ذو حدين لكني في الأمس كنت من معتنقيها.

في سن الشباب انتقلت للدراسة والعمل في محافظة بعيدة. كان وقوفي أمام المدينة الضخمة يصيبني بالخوف. أفكر أني سأضيع في هذه الشوارع من غير درب أستطيع المضي به.
في مكان سكني تعرفت على شاب يكبرني 12 عاماً، يعيش وحيداً في منزله، في قلب المدينة على كرسي متحرك. لم أكن أعرف عندما كنت أراقبه وأدعو له بالشفاء، أنه يعمل ويحقق دخلاً لا أستطيع تحقيقه، ولو عملت لمدة 20 ساعة في اليوم.
يمر من أمامي ولا يلقي التحية، وفي كل يوم يزداد فضولي تجاهه وتجاه حياته، التي تبدو ـ ويا للغرابة ـ طبيعية. جاءت لحظة التعرف عليه عندما سمعت صراخه الغاضب على أطفال الحي، وهم يقومون برمي الحجارة على جرو صغير ويهم بإنقاذه من عصابة الأطفال.
هرب الجرو الصغير إلى حائط عالٍ. عندها، أتى إلى بابي، وطلب مني أحضار الكلب لأنه لا يستطع الوقوف وإمساكه. وخلال دقائق كنت في منزله الذي يشبه أي منزل. نسخن الطعام ومياه الاستحمام للجرو الصغير، وهنا صرت في عالمه الداخلي، ولم أكن اعرف أني سأبقى حتى اليوم.
تواترت الصور المعبأة في رأسي وما تم تخزينه في تفكيري عن الإحسان والمقاربة الخيرية. كنت قد تعلمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أن هؤلاء، الضعفاء المساكين بحاجة دائمة للمساعدة حتى في أقل التفاصيل، وعلينا مساعدتهم من غير أن يطلبوا هم ذلك، وعلينا العطف عليهم لأنهم مخلوقات الله التي يحبها، وعلينا أن نحبها معه. وعلينا تقديم الصدقة لهم، حتى لو لم يكونوا يتسولون المال في الطرقات. كما أن هؤلاء لا يمكنهم امتلاك حياة خاصة بهم مهما حاولوا، وأن أقصى همومهم هي الزواج ليضمنوا وجودهم كحسنة وبركة مع من يساعدهم في الحياة برباط مقدس كالزواج.
لكن ما وجدته كان العكس تماماً. بدا لي كم هم طبيعيون وليسوا بحاجة لبيئة خاصة لتكون حياتهم سعيدة. وتكفي مراقبة حياة أحدهم ليوم كامل أن تبرهن كم هم طبيعيون، فالتغيير يبدأ بالأشياء الصغيرة وأنا بدأ تغييري مع صديقي وعلى يديه.
صديقي اختار الوحدة، وكان لا يؤمن بالزواج. يحاول الاستقلال والاستقرار. كان غاضباً على نحو مجهول ويضحك للحد الذي تكشف ضحكاته عن حزن بعيد ومتصاعد. ولا يفكر إلا بما أفكر به أنا الشخص “الطبيعي”. تحقيق الذات والنجاح والأهداف. بل حتى أن هذا التفكير بالنجاح بدأ يتحول إلى صراع يخوضه مع نفسه وأنا كنت الشاهد الوحيد على الصراع وما بعد الصراع وفي النهاية العلاج.
كان يصرخ ويكرر مع كل يوم يمضي، بأن روحه تجف وأيامه تتشابه، والقطار الذي يسير بالكوكب الى الأمام. لا مكان له عليه مهما أنتظر في المحطات الباردة. “المدينة وناسها يخنقوني”.
علاقتي به حذرة فلا أستطيع التنبؤ بحالته المزاجية، وأعرف مسبقاً نظرته تجاه الأشياء. هذه النظرة التي يكتسيها الموت والمعاناة.
وبإحساس غريب بدا لي أن وجوده في حياتي هدية من روح والدي التي تطوف فوقي كما أخبرتنا والدتي على القبر عندما كنت طفلاً.

خلال شهور قليلة كان له أثر مباشر على حياتي، ومن غير أن يريد ذلك علمني كيف أنصب فخاخ الحب لخطيبتي وكيف أقبلها. وحفزني حبه للاطلاع على قراءة الروايات. كما كنا نشاهد السينما بشكل دوري، وخلال هذه الأيام كانت حياتي تتحسن، وبدأت اشعر أنى أحقق نفسي. لأني ربما اخترت الصحبة الجيدة أو لأني كنت بحاجة النصيحة. ومع تحسن حياتي وعملي الناجح. كنت أراه ينظر إلى الموت بعين واثقة من غير أن يتكلم عن مشاعره ولا لمرة واحدة مهما حاولت استدراجه بالحديث. لأنه وفي كل مرة كان أصلب مني ويجد طريقة للتهرب من الحديث عن الماضي الذي سبب له كل هذه المعاناة.
الرابعة صباحاً في الشتاء. كانت السماء تمطر في الخارج. وأنا أبكي على باب العناية المشددة في المشفى، وصديقي على السرير وحيد وغاضب كما أعرفه يفصلني عنه باب زجاجي وحزنه المجهول الذي دفعه لهذا التصرف.
فكرت حينها في أبي وفي روحه التي تطوف فوقي، وأنا أنظر عبر الزجاج إلى صديقي، وهو يمضي في طريقه الأخير غير مبال بأي شيء كان. كنت مرافقه لمدة 3 سنوات وأحسست بأني أفقده وأفكر هل وقوفي بجانبه هو مقاربة خيرية كما علمونا في الطفولة. أم أن علاقتي به بمرور الوقت أخذت طبيعتها وخلقت طابعها الخاص.
وفي الخارج حدثني الطبيب عن حالته الجسدية والنفسية، وتفاجأت عندما سمعت بمرض القرحة السريرية والاكتئاب الحاد والذهان، في رأس صديقي الحزين. وكيف أنه ومن غير قصد أو إرادة منه تحولت عاقته من جسدية الى إعاقة متعددة جسدية ونفسية ومجتمعية. وكما يقول الطبيب، أنه علينا دق نواقيس الخطر لإنقاذ ذوي الإعاقة اليوم قبل الغد.
عندما استفاق سألني ان كنت قد أطعمت الكلب وصمتنا بقية اليوم.

الإعاقة المتعددة هي إعاقة جسدية ونفسية ومجتمعية تبدأ بالشخص المعاق وتنتهي بضرر جسيم له ولمحيطه قد يصل للموت.
في الحقيقة أيضا. أن الإعاقة النفسية خطيرة للغاية عندما يكون الشخص من ذوي الإعاقة وهي تتطلب برامج ضخمة وقوية لعلاجها، وليست كما هي في حالة الشخص الذي من غير إعاقة.
إن امراض مثل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والفصام والذهان وثنائي القطب، هي تشخيصات متكررة لدى ذوي الإعاقة ومجهولة بالنسبة لهم. وخصوصا في مجتمعات ما بعد الحرب حيث تزداد الجريمة والفقر والمخدرات ويغيب الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والدمج، ويأخذ رغيف الخبز الأولوية.
وهذا ما رأيته حقيقة عندا تم تشخيصه بالاكتئاب الحاد والهذيان والإحباط ووضعوا له خطة للتخلص من ادمان الكحول وادوية للاكتئاب وعلاج سيستمر لمدة عام كامل، على نفقته الشخصية. وخلال هذه الفترة كنت اراقبه، وأفكر في أسباب الإعاقة المتعددة وما هي طرق علاجها ومحاربتها، كي أضمن حياة صديقي وغيره من ذوي الإعاقة. وذهبت لأتطوع في برنامج يهتم بالصحة النفسية لذوي الإعاقة. لأنني اكتشفت أهمية هذه الفئة وقدرتها على الابداع والتغيير رغم تعرضها المقصود للتمييز والاقصاء، ولأرد الجميل الذي فعله بحياتي من غير إرادة. في أن أجعل من أجالسهم في حياتي على الأقل، يعرفون ما هي الإعاقة والدمج وكيف أن ذوي الإعاقة يعيشون في معارك مستمرة لا تظهر للعلن حتى الرمق الأخير. ومع تطوعي واهتمامي، كان صديقي يتحسن على العلاج النفسي والطبيب يتابع حالته بشكل دوري وممل للغاية.
اليوم وبعد كل شيء أسأل نفسي؟
هل أنا مرافق أو كنت مرافقاً خلال هذه السنوات؟ وإذا كنت مرافقاً فما هو تعريف الصديق؟
أبحث عن الأخطاء وأجدها كثيرة، ولكن يمكن تصحيحها تماماً كما حصل معي ومع مقاربتي الخيرية التي أضحك عندما أفكر بها الآن.