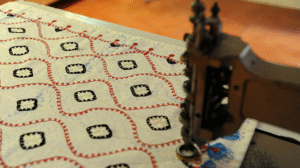وسيم كناكرية
دموع سنديانة الساحل التي لم أرَها، وحراستها لجثثٍ لم أعرف ملامحها، وعبارة “الله لا يسامحك” التي قالتها لأشخاصٍ تشبه أصواتهم أصواتنا، كل ذلك جعلني أتساءل: هل للإجرام وجه؟ ما هو الشيء الذي لا أراه؟ وهل نحن، كسوريين، يستحيل أن نتعايش بسلام؟ خاصة أننا جميعاً كنا تحت ظل نظامٍ مجرمٍ لمدة خمسة عقود، عمل خلالها على تغذية النعرات الطائفية والعرقية بين جميع مكونات المجتمع، أو بشكلٍ أوضح، بين جميع المكونات التي لها ثقلٌ في المجتمع، ونحن، بالتأكيد، كأشخاصٍ من ذوي الإعاقة البصرية، لسنا منهم.

في حين كانت الدماء تنزف في الساحل الحبيب، ذاك الساحل الذي يحمل مكانةً خاصةً في قلوب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، كنتُ أنا وأصدقائي على مائدة الإفطار، مائدةٍ تبدو غريبةَ المعالم أو حتى صعبةَ التصديق في أيامنا هذه. فقد كنا على طاولةٍ واحدةٍ، نحن السني والشيعي والعلوي والدرزي والإسماعيلي، نأكل من نفس الطعام، ونشرب من نفس الماء. لم أسأل إن كان فلانٌ صائماً احتراماً للصائمين، ولم أسأل ماذا يقول فلانٌ قبل الإفطار. لم تخطر هذه الفوارق في ذهني، وأجزم أنها لم تخطر في أذهانهم أيضًا.
لكني اليوم، وبعد سماع صوت أم أيمن، سألت نفسي: لو كان وطننا غرفة الإفطار تلك، وأم أيمن هي أم صديقي، فهل كانت ستبكي يومها؟ أم كانت ستضحك، وتحلف علينا أن نأكل المزيد، وتقول إنها لن تسامح من يقوم عن الطعام دون أن يشبع، أو يأخذ لقمةً إضافيةً من يدها؟
مشهد الإفطار الذي ذكرته ليس غريباً على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، كيف لا، ونحن الذين تربَّينا منذ الطفولة في مدرسةٍ واحدة؟ وعندما أنهينا المرحلة الثانوية، جمعتنا الجامعة والسكن الجامعي، وبعد الجامعة، جمعتنا الجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، والأندية الرياضية، والنشاطات الموسيقية والمسرحية، والأهم من ذلك كله، جمعنا الكفاح المشترك ضد تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. كما جمعتنا نظرة المجتمع السلبية لنا دون التفريق بين طائفةٍ وأخرى. كل ذلك جعلنا، نحن المكفوفين، نبصر أن ما يجمعنا كبشرٍ أكثر بكثيرٍ مما يفرقنا، وأن نعمة فقدان البصر قد جنَّبتنا الكثير من المآسي، مآسٍ نتمنى أن تتوقف في بلادٍ أثكلتها الحروب وأغرقتها الدماء.

تكلَّم لأراك
قديماً قال الفيلسوف اليوناني سقراط: “تكلم لأراك”، وربما لم يدرك أن مقولته ستعبر عن شريحةٍ كاملةٍ من المجتمع، شريحةٍ لا يعنيها شكلٌ ولا لون، شريحةٍ تُبصر بآذانٍ مصغية، يكفيها أن تسمع صوت من أمامها لتعرف أنه موجود، موجودٌ كإنسان، بغض النظر عن أي شيءٍ آخر.
ما يميز الصوت أنه لا ينقل المظهر الخارجي، ذلك المظهر الذي كان سببَ معظمِ مصائب البشرية، من تصنيفاتٍ عرقيةٍ وصورٍ نمطية. فإن تكلمتَ أمامي، لن أعرف إن كنتَ من ذوي البشرة السمراء أو البيضاء، أو حتى إن كنتَ من خارج الكوكب ببشرةٍ خضراء. كما أن الصوت لا يخبرنا إن كان الرجل بلحيةٍ أو بدون، أو إن كانت السيدة التي تحدثنا محجبةً أو حتى عاريةً تمامًا، أو إن كان الشخص الذي أمامنا من ذوي الإعاقة. كل ما يخبرنا به الصوت هو أننا نخاطب بشراً لا يختلفون عن غيرهم بشيءٍ في مخيلتنا.
ما يصيبنا يصيبكم، ولكن لا تشعرون
في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، وفي أوج موجة لجوء المواطنين الأوكرانيين إلى دول أوروبا، ظهر مقطعٌ لمراسلٍ صحفيٍ يبكي على هؤلاء اللاجئين، وعلى هذا المنظر الذي لم يعتده. فهو الآن ينظر إلى مواطنين متحضرين، ببشرةٍ بيضاء وعيونٍ زرقاء، كما قال هو، على عكس اللاجئين الذين اعتاد رؤيتهم يصارعون أمواج الموت، أو يرى صورهم مقتولين على شاشات التلفاز.
لم يسأل المراسل عن طائفة اللاجئين أو أعراقهم، فقد كان ينظر إليهم جميعاً نظرةً واحدة. تماماً كما ينظر مجتمعنا إلينا. ولكن نحن، كأشخاصٍ من ذوي الإعاقة البصرية، استفدنا من هذه النظرة، فصرنا وحدةً واحدةً، مهما فعلنا، سنظلُّ بالنسبة للمجتمع في الصورة النمطية ذاتها. فهل يستفيد مجتمعنا من تجربتنا؟ هل يدرك أننا جميعاً، بغض النظر عن الإعاقة والعرق والطائفة، سواسية؟ هل يعلم أننا جميعاً نندرج تحت مسمى “دولةٍ من العالم الثالث”، لا تصلح إلا لتجريب الأسلحة على شعبها، تلك الأسلحة التي لا تفرِّق بين أحد، ولا تصلح إلا لسرقة مواردها، أو لخلق الاقتتال بين أبنائها، ليصدِّروا لشعوبهم صورة أن هؤلاء هم الهمج، وأنهم هم المتفوقون؟