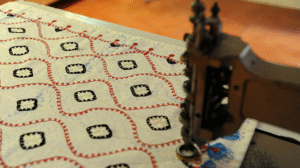خليل سرحيل
يخيل لنا نحن سكان مناطق الصراع والكوارث والحروب أننا مصابون بلعنة أو تعويذة تجبر أقدامنا على الرحيل من غير اتجاه. تجبر عيوننا على النظر إلى اللامكان. وفي أحيان أخرى تجبر سقوف منازلنا على التحرك.
ننظر إلى حروبنا نحن، نراها حروبًا مستمرة منذ أكثر من 50 عامًا. شاهد أجدادنا الدماء والأشلاء ذاتها، وخاف أبناؤهم من وصفها قبل أن يروها، وبدورهم كان لهم نصيبهم فيها في مكان ما ولحظة ما، ونقلوها لنا عبر الجينات والأنساب والتاريخ، كما ينقل لنا الاسم والدين. وأصبحنا بشكل حتمي منسوبين بالقوة وبالضرورة إلى حرب ما، في مكان ما، ولسبب ما..

اعتياد ما لا يُعتاد
يقول الدكتور فيكتور فرانكل: “إن رد الفعل غير السوي إزاء موقف غير سوي هو استجابة سوية“.
في الشارع، يتحرك الناس كما كل يوم منذ بدأت الحرب الجديدة مسلوبين من الابتسامات، بائع الخضرة تحت بيتي يلقي نفس النكتة التي ألقاها يوم أمس، وجارنا يضحك نفس الضحكة. يسكتان قليلاً قبل أن يشتكي جارنا من سعر البندورة ويقول له البائع، استنى بكرة رح تغلى أكتر إذا ما وقفت الحرب. أتساءل؟ هل يمكن أن تُختصر أرقام الحرب بمؤشر ارتفاع سعر البندورة بهذه السهولة؟ هل هو فقدان الشعور؟ التعود؟ التبلد؟ الهروب من تفكير لا يسفر إلا عن قلق؟ ربما أصبح الاعتياد على العنف جزءًا من الحياة اليومية، فقد عهدناه سابقاً وربما بقي في جوفنا لم يخرج. ما كان يومًا مرعبًا ومثيرًا للقلق، تحول بمرور الوقت إلى مشهد مألوف، شبه عادي. لا شيء جديد في حرب لبنان اليوم، أصوات القصف والانفجارات، قوافل النازحين، بكاء الأمهات والعيون الجافة لأطفال تجمدت دموعهم من هول الصدمة… والعجز، العجز، كله ذاته وقد خبرناه ما فيه الكفاية.
هذا الاعتياد لا يعني أن الألم والخوف قد زالا ، بل يعني أن الإنسان قد وجد طريقة للتعايش معهما. أصبح الألم جزءًا من الذاكرة الجماعية، والخوف تحول إلى حذر دائم. في هذه البلاد، يصبح من الطبيعي أن ترى الدمار حولك ، وأن تسمع قصص الفقدان والمعاناة كأنها أخبار عادية. وأنت تبحث في هذا الدمار عن نجاتك ...
الخوف المستتر بورقة توت
يقول أمين معلوف: “أستطيع أن أشهد بأنه ما من حرب هي نزهة، غير أن الأمم نسّاءة والبارود مسكر”.
تتساءل صديقتي، هل ستصل الحرب إلينا أم سنستقبل اللاجئين فقط؟ هل سندفن الأحباء مجدداً؟ أتساءل بدوري، هل غادرتنا الحرب قط؟ هل صدقنا أن القدر أعطانا فرصة ثانية؟ وهل نحن ممسكون بهذه الفرصة إن وجدت. دائرة الحروب تلتف على مصائرنا فتغير منها الكثير، دوامة مغلقة من النزوح والهرب والاختباء ما زلنا ندور فيها منذ عقد وربما منذ عقود أسأل نفسي ؟أليست النجاة هي من صفات الحضارات ؟ أنظر الى حضارتي واًصمت. قتلت الحرب من قتلت، وقتل البحر الكثير في محاولات الهجرة إلى الخارج، ومات آخرون في الغابات الباردة. خوف آخر ظهر في أذهاننا وهو الزلزال، خوف جديد ولم يكن بالحسبان. بل حتى لم يروِ الأجداد لنا عنه أي شيء. وهنا انضمت الأرض بكل أهميتها الجغرافية والتاريخية إلى شلة القتل، والبقية التي نجت، ممن بقوا في البلاد يستنزفون اقتصاديًا وينزفون نفسيًا، حيث لا يخفت صوت الحرب من المشهد اليومي، كأنه الموسيقى التصويرية لحيواتنا. الذاكرة فائضة بالخوف والألم… تركة شرعية من التوابيت المتنوعة في رسم جيل لم يعرف الحياة إلا كمرادف للموت.
شريط منوعات لا ينته:
يقول جان بول سارتر: “لا يوجد شهود على العنف، بل شركاء فيه فقط”. لكن ألسنا كلنا مجرد متفرجين؟
تشاهد أمي المسلسل التركي “الوحش”. تنتهي الحلقة دون أن تعرف من القاتل. على انستغرام، أشاهد صور الجرحى في بيروت، بعدها أقرأ حكمة نفسية وأشاهد مقطعاً سريعاً لصنع الكاتو بالنسكافيه ثم تعود إلى شاشتي صور توزيع الطعام على النازحين.
في عصر السوشيال ميديا، تُعرض الحرب على شاشاتنا كأنها لعبة فيديو تذكرنا بما عشناه وتضيء على حياتنا الخجولة بعد الحرب، كأنها حلم يريد أن يستريح فيه من هم في الحرب الآن . مشاهد الدمار والانفجارات تُبث مباشرة إلى منازلنا. نشاهدها من خلف الشاشات الصغيرة. المشاهد التي يفترض أن تخلق الرعب والحزن، أصبحت جزءًا من الترفيه اليومي. نفقد الإحساس بالواقع، حيث يصبح ما يجري لنا مجرد قصة تُروى لنا. فالذاكرة حتى وان ادعت النسيان .فهي تذكر جيداً . ولهذا قال لنا الجميع إنه علينا أن لا نتعود على قسوة الحرب، ولكننا فشلنا رغبة بالحياة.
هذا الانفصال يجعلنا نتعامل مع الواقع ببرود، حيث نتناسى أن وراء كل مشهد هناك حياة تُدمر، وأسر تفقد أحباءها، وأطفال يكبرون في ظل الخوف والدمار. نتناسى أن الحرب ليست مجرد مشهد بصري لشريط منوعات تقطعه إعلانات عن الحياة العادية. ونتناسى أننا كنا بها يوماً ولربما لانزال .لا أحد يعرف، الانتظار لحظة أبدية مستمرة.
تكرار لصدمات متشابهة
“الأخبار؟ انتظر، انتظر، سيطول الانتظار أيها المسافر، ستموت قبل أن تسمع الكلمات التي تنتظرها. شاطئ المتوسط الشرقي لا يلد إلا المسوخ والجراء، وأنت تنتظر الخيول والسيوف!” من رواية شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف.
كل الأماكن غير صالحة للعيش إذا ما نظرنا إلى القطاعات الخدمية الموجودة على سبيل المثال في سورية ولبنان. لا كهرباء، ولا طبابة أو مستشفيات، ومن غير مرافق من شأنها إحداث فارق لما يحصل. حتى البيوت والمباني التي لم تنل منها الصواريخ، نال منها الزلزال. ومن لم ينل منه الفقد، نال منه الخوف.
خوف يتمثل بمعاناة الأطفال من تبعات أصوات القصف وتغير بيئة العيش حيث الخيام ، خوف الآباء من عدم تحصيل الطعام لعائلاتهم، خوف من المجاهرة بالخوف في مكان لا يعترف بالعلاج النفسي وأهميته ولا حتى ينادي به.
أما فيما يخص ذوي الإعاقة، من فقدوا أحد أحبائهم، والذين خسروا بيوتهم، ومن يكافحون ليل نهار ليكملوا حياتهم بأدنى مقومات الحياة. اليوم يشعرون بصدمة جديدة تذكرهم بالماضي القريب وتحد جديد للبقاء. صدمة تعيد استحضار ذكريات وآلاماً وقصصاً كنا نسعى جاهدين لنسيانها . صدمة قد تكون آليات الدفاع الوحيدة المتاحة في مواجهتها، هي ادعاء أنها بعيدة عنا. وتصديق الكذبة ومتابعة التصفح.
نقف أمام أوطاننا كما وقف شعراؤنا قديمًا على الأطلال، وكان اليأس والبكاء على الماضي هو قناعتنا بالحياة. وأفكارنا عن الغد لم تعد ملكنا منذ زمن بعيد. بماذا نحلم الآن؟ وهل هناك أحلام تقابل فعل النجاة من الموت الواقع، النجاة من الفقر والعوز والبحث عن مسكن جديد.
نقف على أوطاننا وفي أذهاننا نعرف جيداُ أننا لسنا سبب هذا الخراب . بل نحن أجمل ما فيه، ونمضي… كما قال محمود درويش: “أنا للطريق هناك من سبقت خطاه خطاي…”.