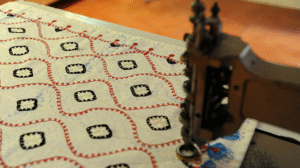خليل سرحيل
كحال الجميع، رافقتني أمي في جميع محطات حياتي، بكت وفرحت معي، غضبت وشتمت معي، لكن تاريخي تغير. رأيت، وأنا في سريري انكسارها وهي تسهر بجانبي في مشافي المدينة العفنة. في سيارة الإسعاف، يوم تحولت حياتي، كانت ترتدي معطفاً أحمر مثل دمي المهدور. تنظر إليّ، وتبتسم، وتمسد بيدها على قدمي التي لم أعد أشعر بها، وكثيراً ما كنت أعود في ذاكرتي وأكرر هذا المشهد… وأختنق.
جاء الأقارب والأصدقاء إلى العناية ورحلوا، منهم من دعا لي بالشفاء ومنهم من قال، لو أنه مات كان الأمر أفضل له، ولكن أمي بقيت على باب العناية لمدة شهر كامل، تتسلل إليّ كلما سنحت لها الفرصة، تنقل لي أخبار الزوار وتمسد قدمي، أسمعها وأنظر إليها للأعلى عبر القساطر والمحاليل الموصولة بجسدي. أحاول الكلام ولا أستطيع، فدمي ملأ رئتيّ وقناع الإنعاش يغطي فمي.

في داخلي كنت أعرف أن إدماني للمسكنات ليس لآلامي الجسدية. بل كنت أراها مسكّناً لروحي ولذاتي العميقة التي لم تحقق شيئا يمكنها الافتخار به. أقرأ الكتب والروايات وأشاهد الأفلام التي كانت بالنسبة لي نافذتي على العالم الذي كنت جزءاً منه فيما مضى.
في عمر الـ29 بدأت في دراستي الجامعية، ورحلت عن منزل أمي إلى المدينة التي كنت أشاهدها من نافذتي البعيدة كل يوم، أحمل أحلامي التي قررت أن أصيرها وأعرف أن الطريق شاق وقاس، ولكني قررت المضي به. وتخليت عن الترامادول وسكنت بمفردي في قلب المدينة، تزورني أمي بشكل شبه يومي، ترتب منزلي وتطبخ الطعام لي وتعود إلى منزلها. لم أكن أعرف حينها أني أستطيع الطبخ والترتيب. حتى اليوم الذي جاء جاري وصديقي من ذوي الإعاقة لزيارتي، ووبخني لأني أجبر أمي على المجيء وفعل الأشياء التافهة حسب قوله.
علمني طريقته في التنظيف لأن إعاقته أقدم من إعاقتي وبالتالي خبرته أكبر، كونه يعيش وحيداً منذ مدة، وبالفعل بدأ فصل جديد في حياتي لا تزورني أمي فيه سوى لنقل الملابس النظيفة، وبالطبع تجلب طعامها اللذيد. وأنا أرتب وأطبخ على الكرسي المتحرك. ولمدة 5 سنوات كان استقلالي أحد أهم الأشياء التي أفتخر بها وأعتبرها إنجازاً ضخماً على الصعيد الشخصي.
حتى اليوم، أمي لا تعرف أني خرجت من المنزل من أجلها أولاً وثم من أجل أحلامي. حاولت واستطعت أن أهديها ما تريده كل أم من أبنائها، الشهادة الجامعية والقدرة على الاستقلال والعمل. فأنا لم أرد أن تكون صورتي لدى امي، ذلك الطفل الذي عاكسه القدر ويحتاج للرعاية بشكل يومي، بل طفل له مكانه الحقيقي في المجتمع، ويتعامل بطريقته الخاصة مع حياته.

وحيداً في المنزل، تحاصرني أمي، حتى أصبحت أشعر أن اهتمامها استحال إلى تدخل في حياتي الخاصة، فهي أصبحت تعرف كل تفاصيلي كأنها في داخلي
اليوم انتهت حياتي الجامعية، والشهادة التي لن أعمل بها معلقة في غرفة الجلوس، تريد أمي من جميع الزوار رؤيتها والتفاخر بما فعلته أنا ابنها. عدت بعد التخرج وأنا بعمر الـ 34 إلى منزل والدتي طفلاً للمرة الثالثة. أحاول الآن أن أخطط لمستقبلي ولحياتي القادمة بعد التخرج. وبدأت أبحث عن مزل للإيجار في المدينة التي كنت أظنها بعيدة، وأدخل في الشهر الثالث من البحث عن المنزل الذي تستطيع الكرسي المتحرك دخوله وليس أنا، فأنا أعرف أني أستطيع.
تحاول أمي محاصرتي والتعامل معي على أنني ذلك الطفل. لكنها شعرت بأن شيئاً ما قد تغير. فأنا طهوت لها ما تعلمته في منزلي ورتبت غرفتي أمامها وصنعت لها قهوة الصباح وقدمتها على صينية في حضني بقدمي التي لا أشعر بها.
تساعدني اليوم أمي في البحث عن منزل، تعيد المواصفات المطلوبة على مسامعي كي تقارنها في المنازل التي تذهب لفحصها من أجلي في المدينة.الآن أعود بذاكرتي إلى مشهد سيارة الإسعاف وأرى أمي تبتسم وأشعر بأنها ابتسامة حقيقية مليئة بالإيمان. أمي تبتسم لأنها آمنت بي وأنا لن أخذلها أبداً.