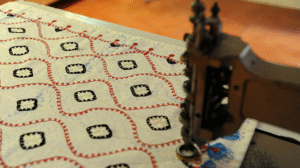شيماء شريف
يسألني الناس عندما يقابلونني، ما قصتك؟
أعرف قصتي بالتفصيل، لكني لا أذكر أي شيء منها. لقد قيلت لي مراراً وتكراراً، حتى أكاد أرى جسدي يتطاير وأبحث عن يد أخي في غبارٍ كوني انفجر على هذه البقعة الجغرافية. كنت أقف في طابور الخبز للساعة الخامسة على التوالي مع أخي الأصغر عندما وقعت بجانبي قذيفة هاون. كان هناك عسكري ينظم الدور، يصرخ في وجه الجميع، ويضرب الواقفين بالسوط أحياناً، أو بيده أحياناً أخرى، كان ينفجر غاضباً لأن بعض الواقفين يتذمرون من طول الانتظار أو يستفسرون إذا ما كان الخبز سيكفيهم جميعا أم لا.
لا يمكنني تذكر أي شيء مما حدث بعد هذه اللحظة. بين حينٍ وآخر، أسمع بقية الأحداث من أمي. قصتي هي قصة إصابتي. أليس من الغريب أن تختصر قصتنا كبشر بحدث واحد لا نتذكره.
يخبرني عمر التركي وهو شاب لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره يعيش في دير الزور بقصته التي يحملها معه ويحلم باليوم الذي يلقيها بعيداً عنه كي يكون لديه قصة أخرى ليرويها.

دمشق 2016، فتحت عيناي ووجدت أمي بجانبي. عندما رأتني أستيقظ من الغيبوبة، وقفت وبدأت تذرع الغرفة وتفتح باب الغرفة، تقف بجانبه قليلاً ثم تعود لتنظر إليّ وكأنها ترى جثة قد بُعثت إلى حياة من جديد. لم تكن سعيدة بقدر ما كانت مذعورة. أحتاج منها الأمر بضع دقائق قبل أن تكلمني: عموري يا حبيبي.. صحيت.. دخيلك يا إمي الحمدلله… ثم آخ طويلة، ثم شهقة مخنوقة، ثم جاءت موجة البكاء التي لاتزال زفراتها تمزق قلبي إلى اليوم. لا أذكر أن أمي بكت هكذا في كل حياتي إلا في يوم وفاة والدي.
علمت لاحقاً بأننا أصبحنا في دمشق. بسبب إصابتي، سُمح لعائلتي المؤلفة من أمي وأختي وأخي الأصغر الخروج من الحصار في دير الزور بعد عامين من الجوع والرعب.
لمن لا يعرف فقد حاصر تنظيم داعش مدينة دير الزور عام 2014. منح الأخير مهلة قصيرة للأهالي لمغادرة المدينة والتوجه إلى الريف الذي كان تحت سيطرته أيضاً. بعد انتهاء المهلة اعتبرت داعش كل من في المدينة مرتدين فلم تسمح لأحد بالدخول أو الخروج من المدينة، وأغلقت جميع المعابر البرية والمائية في وجه المواد الغذائية والأدوية والمحروقات لتعيش دير الزور جحيم حصار استمر حتى هزيمة داعش عام 2018.
كل ما أرجوه أنا وبقية الأطفال من ذوي الإعاقة هو أن تتركوا لنا مكاناً بجانبكم لنعيش وندرس ونعمل ونحلم. لا نريد البقاء في تلك الزاوية المعتمة على طرف الحياة، هناك كخيال خافت ينزف دماً، فيما كل من حوله يعبر الطريق غير مكترث بهذا الوجه الشاحب الذي يفتش عن تفسير لما حدث.
قبل الحصار، كان الجوع بالنسبة إلينا هو الوقت الذي يسبق وجبة الطعام، كنا نجوع بين الغداء والعشاء، أما في الحصار فإن الجوع شيءٌ آخر. كنا نجوع لعدة أيام لا نجد فيها حتى كسرة الخبز. كنا نحضر الخبز المتعفن لأمي لتمسح العفونة عنه، وتبلله بقليلٍ من الماء لنتمكن من تناوله. كان هذا يحدث تقريباً مرة كل أسبوع على الأقل. لا أزال أتذكر يوم قررت أمي أن تسعدنا بشيء مبالغ فيه. أحضرت معها نصف كيلو لبن. وكانت تتمنى شراء كأس أو نصف كأس من الرز ولكنه يحتاج إلى طبخ، ونحن لا نملك أي وقود فعدلت أمي عن قرارها وأخبرتنا بأنها ستحضر لنا فتة لبن وبدأت تصف لنا كيف أنها ستقطع الخبز وتضع عليه اللبن. كادت أعصابنا تنفصل من شدة الحماس لهذه الوليمة إلى أن قررت أمي الدخول إلى المطبخ لتجد أخي الصغير أنس وقد تناول اللبن كله. لم يقاوم أخي الأصغر إغراء صحن اللبن الذي لم يره منذ عدة شهور فلم يترك لنا شيئاً سوى القليل جداً جداً من اللبن الملتصق في قعر الوعاء. لم تقل أمي شيئاً، ولكنها خرجت من الدار كالداخل إلى النار، كانت تفكر بما يمكن أن تطعمه لنا بعد أن تناول أنس صحن اللبن. بالنسبة إليها كانت الخسارة فادحة لكنها رجعت إلينا وقالت لأنس أخيراً، صحتين وعوافي يا حبيبي…
انتهى الحصار وخسائري بدأت. لم أكن أشعر في بداية إصابتي بالعواقب. كنت سعيداً بالاهتمام الذي أتلقاه من الأقارب والعائلة. ولكن مع مرور الشهور والسنين، علمت بأني لن أستعيد عيني التي فقدتها، ولن تخرج الشظايا من جسدي. وأنّ علي أن أتأقلم مع وضعي الحالي، وأن أحب نفسي على أيّة حال. أعترف أني أصبحت شديد العصبية والحساسية ولكنني بقيت ذات الشخص طيب القلب الذي تبكيه أبسط الأشياء. قررت تعويض ما حدث لي بالاجتهاد والدراسة. ثأرت من كل شظية بقلم، وغطيت كل جرح بكتاب. وبالفعل حصلت على علامات مرتفعة وأصبحت من الأوائل وحافظت على هذه النتيجة وها أنا الآن في الصف الحادي عشر الثانوي. وما زلت أبحث عن شيء أضعه في كفة الميزان ليقابل عيني المفقودة.
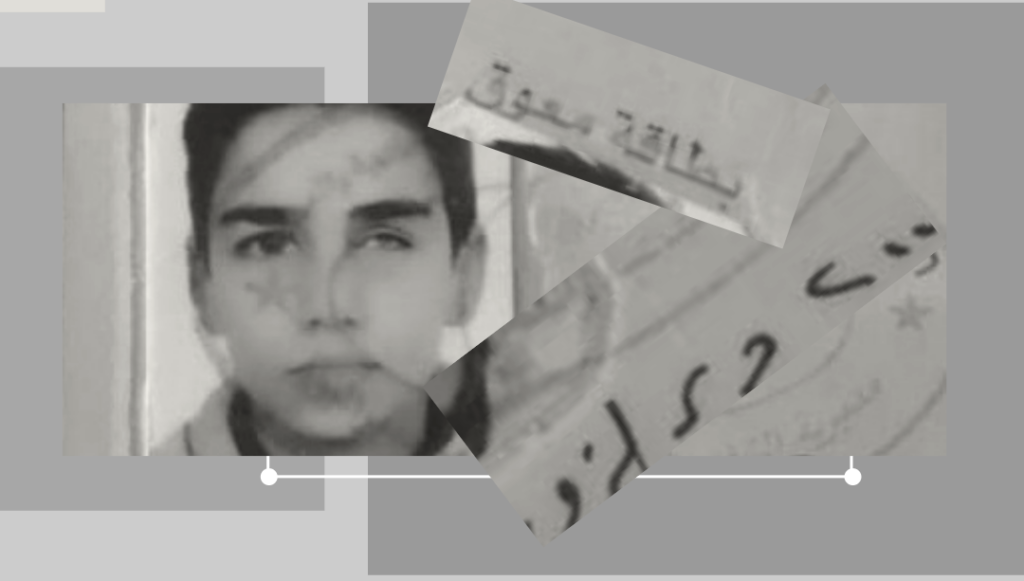
بين الحين والآخر، أنقم لكوني ولدت في سورية. بالتأكيد وجودي على هذه الأرض في سنوات الرعب هذه كان السبب المباشر لتغير مسار حياتي. بلا شك أن الجغرافية التي يولد فيها الإنسان تلعب دوراً كبيراً في تغيير مصيره، فإذا كنت تعيش في بلد بارد فستكتسب من الطبيعة لوناً فاتحاً، وإذا كنت تعيش في مكان حار، فغالباً سيكون لونك أكثر سماراً، أما إذا كنت تعيش في سورية، فمن المحتمل جداً أن تفقد أجزاء من جسدك أو أن يتشوه وجهك. غالباً، هذه مقاربة غير منطقية. أنا أعلم هذا ولكن لو ألقيت نظرة الآن على الشارع من شباك غرفتك وقمت بمراقبة عابري السبيل، فستقتنع بمقاربتي هذه، خصوصاً إذا كنت تعيش في أحد المدن التي نالها من الطيب نصيب (وليس الطيب هنا إلا عكسه).
لا بأس. سأكمل رحلتي في هذه الحياة على أية حال. حسبي أنه يمكنني أن أرى وجه أمي بعيني المتبقية، وأن ألمح ارتجاف قلب أخوتي خوفاً عليّ كلما شعروا بأني أبتعد عن الأمل والفرح اللذين طالما تمسكت بهما. فبرأيي الإعاقة الحقيقية هي رداءة الطبع وسرعة الاستسلام وانعدام حبنا لذاتنا.
أنا أعرف أننا أصبحنا كثيرين جداً، ولكن قصصنا لاتشبه بعض، وظروفنا أيضاً مختلفة. ولكن كل ما أرجوه أنا وبقية الأطفال من ذوي الإعاقة هو أن تتركوا لنا مكاناً بجانبكم لنعيش وندرس ونعمل ونحلم. لا نريد البقاء في تلك الزاوية المعتمة على طرف الحياة، هناك كخيال خافت ينزف دماً، فيما كل من حوله يعبر الطريق غير مكترث بهذا الوجه الشاحب الذي يفتش عن تفسير لما حدث. نعم هكذا أنا اشعر، أكبر، أعيش وأنا أكمل تعليمي وأحاول أن أعمل لأعيل عائلتي وغالباً أفشل لأن لا أحد يريدني أن أعمل عنده بعين واحدة وجسم ممزق. لأبقى أسير تلك اللحظة التي لا أذكرها. لا أزال هناك كل الوقت أمام الفرن وكأن السنين والأيام عبرت فوقي وتركتني هناك ممداً يحتضنني أخي الأصغر. عند كل رفض يقابلني في مسيرتي لاستعادة حياتي. عند كل إشاحة وجه عن محاولاتي الاندماج في المجتمع، أعود إلى تلك الحادثة. أقول لنفسي لو أنني لم أذهب يومها إلى الفرن.. لو أني لم أولد هنا.