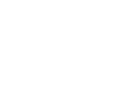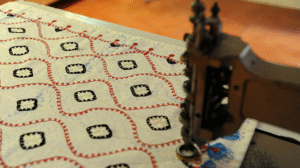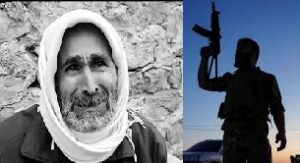مادلين جليس
استطاعت الحرب التي مرت على السوريين أن تجرّب بهم كل أنواع الخسارات والآلام، ولا نبالغ إذا قلنا أنّنا نحتاج سجل خاص نروي فيه حكايات جميع الأيدي والأرجل… والأرواح، التي فقدت وتناثرت شظاياها تحت الركام والأنقاض وما بين البنادق والرشاشات من جهة والخطابات والمانشيتات من جهة أخرى.
لكن الحياة تمشي للأمام كما يقولون، وكثير من الناس كان مجبراً على دفن خساراته دون غسلها وتكفينها بما يليق بها من حزن وحداد، أو حاول تغطية جراحه بما يملك من مساحيق تجميلية تخفي ما لا يريد هو نفسه أن يراه أو يتذكره.

يروي أنس كيف استطاع بتر قدميه أن يعيد تشكيل حياته: “لم أصبح شخصاً يمشي على عكّازين، ولا حتى برجل واحدة فقط، إنهما قدمان، قُطعا، تم محيهم من الوجود، ولم يعد لهما أيّ أثر”، ويضيف “لا أذكر عدد المرّات التي صرخت فيها في وجه أمي وهي تواسيني، ولا كمَّ الأفكار التي راودتني لإنهاء حياتي، وإنهاء رحلة العذاب التي بدأت منذ أشهر ولم تعرف طريق النهاية، ولن تعرفه أبداً”.

الخطة العلاجية المفقودة:
الحديث عن الانتحار، وعن إنهاء المعاناة ليس حالة استثنائية، فأغلب الأشخاص الذين تعرضوا لحالات فقدانِ جزءٍ من أجسامهم أو طرفٍ من أطرافهم أو أحد حواسهم، وصلوا لهذه المرحلة من الضغط النفسي الشديد، وهو ما يتعرض له حوالي 70% من هؤلاء، كما يؤكّد الطبيب النفسي مازن حيدر، خاصة في حال عدم تلقي الشخص الدعم النفسي المناسب، الأمر الذي يسبب له رضوض نفسية عميقة، تبدأ بالاكتئاب وتصل إلى محاولات الانتحار، ويرى حيدر أن وجود خطة دعم نفسي وبرنامج علاجي متكامل، يسرّع عملية التأقلم والتقبل وعودة الشخص لحياته الطبيعية.
بالنسبة لميرنا التي خسرت رحمها وهي في الثالثة والعشرين بعد إصابة مباشرة في بطنها، فإنها ترفض حتى الآن تلقي أي نوع من الاستشارة النفسية، وتتحدث عن استحالة شعور أي أحد بألمها الداخلي الذي لا يراه أحد ولا يعرف بخسارتها سوى دائرة ضيقة من العائلة، وتضيف أن عدم التحدث بهذا الأمر يشعرها بالأمان، وعندما تفكر بمشاركة ذلك حتى مع معالج نفسي فذلك يشكل حالة رعب لها.
لا يطلب كثير من الأشخاص مساعدة الطب النفسي لأسباب كثيرة منها قلة أعداد الأطباء النفسيين في سوريا وتكلفة الجلسات المرتفعة، إضافة إلى عدم وجود تصور واضح لعمل الطبيب النفسي وأخلاقيات هذه المهنة ووجود حالة فقدان ثقة مع المحيط بشكل عام. ومن الملاحظ في السنوات الأخيرة، انتشار لافتات المعالجين النفسيين في الشوارع أو الإعلان عن دورات وورشات عمل مدعومة من بعض المنظمات لما يسمى “الشفاء الذاتي” حيث يتجه كثيرون لها بغية مساعدتهم على إيجاد توازنهم النفسي بعد حالة الفقد سواء النفسية أو الجسدية، إلا أنّ الدكتور حيدر يرى أن هناك بعض الفوضى التي قد تسبب إرباك لبعض الناس وأحياناً قد تؤدي لتدهور وضعهم النفسي، فتحديد هذه المشكلات، وتشخيص الحالة بالشكل العلمي والطبي الصحيح يبدأ من الطبيب النفسي، الذي يستطيع تقدير حاجة المريض للعلاج المناسب، كما أنّه يضع الخطة العلاجية التي يتبعها المعالج أو الأخصائي النفسي، ويضيف أن كل تدخل نفسي لا يستند إلى خطة علاج لا يعدو كونه تخفيفاً أو طبطبة، وهذا قد يترتب عليه إحباط المريض ويأسه من التدخل النفسي الذي لم يلب احتياجاته للشفاء.

نسبية التأقلم
مع كل ذلك يشير الدكتور إلى وجود نسبة غير قليلة من الأشخاص الذين اكتسبوا إعاقات، أو خسروا إحدى حواسهم أو إحدى أطرافهم، نتيجة حادث ما، ومع ذلك لم يكن لديهم حالة صدمة شديدة، كما أنهم تقبلوا حالة الإعاقة الجديدة برضا واتزان وهذا أمر طبيعي، مؤكداً أن الصدمة نتيجة الإعاقة حالة طبيعية كما أن تقبّل الإعاقة أيضا حالة طبيعية، ولا يمكن أن تعتبر حالة مرضية أو غير صحيحة، وهو مايسمى بـ ” إرادة التأقلم” التي تكون مرتفعة لدى هؤلاء الأشخاص، وهؤلاء نسبتهم غير قليلة تصل لـ ٤٠ أو ٥٠ ٪ من الناس. لكن ذلك ليس فقط نتيجة إرادة التأقلم لدى الشخص، فهذه الإرادة بحاجة أيضا لآليات تقبل مرتفعة في محيط الشخص العائلي والاجتماعي، والتي قد تكوّن الآليات الدينية جزءاً كبيراً منها.
من الناحية العلمية والنفسية، يصنّف الطب خسارة عضو من الجسم، كخسارة أي شيء في الحياة، منزل أو سيارة أو صديق، لكن وكما يؤكّد الدكتور حيدر فإن خسارة الأعضاء تصنّف بأنها أصعب هذه الخسارات وأعقدها، خاصة بوجود شلل في أكثر من طرف، وهنا قد لا يكون العلاج السلوكي كافٍ وبالتالي يكون المريض بحاجة لعلاج دوائي لفترة غير قليلة، إضافة إلى ذلك، يراجع الطب النفسي نمط حياة وعمل كل شخص، وطبيعته التي تظهر إن كان مثلاً، شخصاً وسواسياً، فهذا قد يكون تأثير الصدمة عليه أعنف، وتأثير الخسارة أصعب، فالوسواسيون أشخاص لا يتقبلون الخسارة بسهولة ويحتاجون لعملية نفسية أكثر تعقيداً ليستطيعوا التعامل مع الوضع الجديد.

سيكولوجيا العبور
بعد خبرته الطويلة في معالجة الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات نفسية جراء إصابتهم بالإعاقة يؤكد الدكتور سليمان كاسوحة الأخصائي في علم النفس أن العلاج يمر بثلاث مراحل وهو مايسمى ب “سيكولوجيا العبور”، أما مراحل هذا العبور فهي ثلاثة، الموت الرمزي والفوضى والخلق.
يضيف الدكتور كاسوحة: علينا عند المعالجة الوصول مع المريض إلى حالة الموت الرمزي، الموت الرمزي للمرحلة السابقة، وللعضو الذي فقد، وإيجاد تختيم داخلي وخارجي لتلك المرحلة، التختيم الخارجي يكون قد تمّ مسبقاً بفقد العضو أو الحاسة، أما التختيم الداخلي فهو اقتناع الشخص المصاب بفقد هذا العضو للأبد ولهذا نطلق عليه الموت الرمزي للعضو، وهذا يأتي من وعي الشخص لعدة نقاط، أيضاً يقوم المعالج بمساعدته فيها.
بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهي الفوضى أو مايمكن تسميته بإعادة التوجه، وفيها بحسب كاسوحة يتم طرح ستة أسئلة، تكون بمثابة فرصة أو وقت مستقطع أو منطقة حيادية للشخص ليتبع بعدها بوصلته ويعود لنفسه، وهذه الأسئلة هي:
- ما الذي أريده في الواقع؟
- ما التناقضات والواجبات التي أثرت علي في حياتي حتى الآن؟
- هل أعيش لأحقق توقعات الآخرين؟
- ماذا سيحدث لو انتهت حياتي الآن اليوم؟
- ماذا أنجزت في حياتي؟
- ما الذي لم أنجزه بعد في حياتي؟
يؤكد كاسوحة أـن هذه الأسئلة مباشرة، لكنها تتضمن إجابات غير مباشرة، ومن خلالها يتنبه الشخص أو المريض لحياته، ولما يريده من الداخل. بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الخلق، ويرى الأخصائي النفسي أن صعوبة هذه المرحلة تأتي من صعوبة قبول الناس للوضع الجديد، ففي هذه المرحلة تكون الرؤية ضبابية، والصور غير واضحة، لكن بعد ذلك يذهب الضباب وتتوضح الرؤية، ويصل الشخص لإدراك ذاته وواقعه، ومايريده في الحقيقة.
لكن العلاج لا ينتهي عند ذلك، فالمعالج عليه أن يزود المريض بآليات تساعده مستقبلاً ليكون قادراً على دعم نفسه، وهو مايتحدث عنه الدكتور كاسوحة، عندما يقول: دائما ما نخرج بمعالجة هؤلاء الأشخاص بإعطائهم عشر نقاط ترافقهم في حال تعرضهم لأي صدمة أخرى، تساعدهم في تجاوز صعوباتهم بأنفسهم، وهو مانطلق عليه اسم “الرعاية المستنيرة للصدمات”.
وعلى الرغم من أن هذه المراحل تبدو صيغة موحدة للعلاج النفسي لكت إدارتها واختلاف تفاصيلها تختلف من شخص لآخر كما أنه لا يوجد وقت محدد لنهايتها، فذلك يتبع لسمات المريض الشخصية إضافة للبيئة الخارجية، أي محيطه الخارجي من الأشخاص، إن كان مستقبلاً داعماً لحالته الجديدة أم لا.