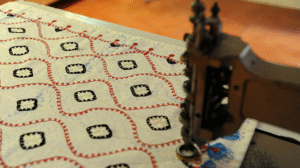شيماء الشريف، منصة إرادة
بينما أنا جالسة أراقب عبد الله، الشابَّ. ذا الاثنين وعشرين عامًا، تذكرت إخوتي ووالديّ. كنا نلتف حول مائدة الفطور كل يوم كما تلتف حبات اللؤلؤ حول العنق. تسكب أمي الشاي، ويعلو صوت غرغرته في الكوب، ويرتفع البخار الدافئ إلى سقف الغرفة، مختلطًا مع البخار المتصاعد من رغيف الخبز الممدد على المدفأة المتربعة وسط الغرفة. كان صوت مضغ الطعام فقط ما يزعجني من كل هذا المهرجان الصباحي اليومي. نفطر بينما رائحة أول هطول للمطر من كل عام تتسلل من نافذتنا وباب غرفتنا المفتوح صيفًا وشتاءً، تتدلى أعلى حافة الباب ستارة عتيقة كما تتدلى الغرة فوق جبين الفتيات الجميلات.


كان حديث عبد الله عن عائلته التي يشتاقها، السبب في انبثاق كل هذه المشاعر من الذاكرة. تلتف كلماته حول وحدته القاسية بعد أن انفصل عن عائلته عام 2019، عندما وصلت نيران الحرب السورية إلى قريته (السوسة) في ريف البوكمال، أقصى شرق مدينة دير الزور. كان عليه أن يبقى لحراسة البيت بعد أن أعلنت قسد (قوات سورية الديمقراطية) والتحالف الأمريكي عن حملة لتطهير القرية من تنظيم الدولة الإسلامية. وبشجاعة أهل الريف الساذجة أحيانًا، بل أغلب الأحيان، قرر عبد الله البقاء في بيته يحرسه ويحرس الأرض، مع أنه لم يكن أكثر من مراهق في السادسة عشرة من عمره. أتخيل يوم وداعه لعائلته وهو يتجنب كعادة الصبية في هذا السن إطالة أمد حضن الأم، أو تقبيل إخوته الصغار أو إظهار دمعة أمام الأب. لم يكن يعلم أحد أنه الوداع الأخير، وبأنه سيودع أيضًا حياته القديمة كلها. بالتأكيد لم يكن يخطر بباله أن صاروخًا للتحالف سيقع بجانب بيته الذي يحرسه. لن يسرق روحه، بل سيبقيها حبيسة جسده بقية حياته. لن يرميه بضعة أمتار بعيداً عن بيته، بل سيرسله إلى مكان مرسل وموحش لا يعرف فيه أحداً.
تم إسعاف عبد الله إلى أحد مشافي الحسكة فقد ظهر مصاب بالشلل التام، وتم إيداعه بعد انتهاء فترة علاجه في مخيم الهول للاجئين، المخيم الأسوأ سمعة على الإطلاق جنوب مدينة الحسكة شمال سورية، بالقرب من الحدود السورية العراقية. كان 2019 العام الذي تمدد فيه المخيم وتضخم ليستوعب أكبر عدد ممكن من الأشخاص النازحين من المناطق التي سيطرت عليها داعش فيما سبق. أصبح المخيم سجنًا قسريًا، بشكل خاص لآلاف النساء والأطفال الخارجين من المناطق التي سيطرت عليها داعش. مع أن قسماً كبيراً من هؤلاء قد تورطوا فعلاً بالانضمام إلى تنظيم (داعش) أو كانوا زوجات وأبناء مقاتلين من التنظيم، إلا أنّ المئات أو ربما الآلاف من المدنيين من غير المتورطين تم زجهم في المخيم الذي يُمنع الخروج والدخول إليه، فضلاً عن الأطفال الأبرياء الذين كُتب عليهم البقاء في المخيم إلى أجل غير محدد. سيمضون طفولتهم وصباهم ولن يعرفوا شيئًا سوى خيام الـ UNHCR، رمال بادية الهول، وكراتين المساعدات.

مخيم الهول هو أحد أكبر مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً في سورية، وكان يضم حتى نهاية السنة الماضية، نحو 50 ألف شخص من السوريين والعراقيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 10 آلاف أجنبي من حوالي 60 دولة أخرى، معظمهم من عوائل مقاتلي الدولة الإسلامية، ممن تماطل دولهم في استعادتهم، أو حتى ترفض إعادتهم، وفي بعض الحالات يقومون "بتجريدهم من جنسياتهم". ويخضع حالياً لسيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد). ويعاني سكان مخيم الهول من ظروف إنسانية صعبة وتفرض عليهم قيود صارمة على الحركة والتنقل. ووصفت منظمة أطباء بلا حدود في سورية مخيم الهول في آخر تقرير لها بأنه سجن ضخم في الهواء الطلق فيما أغلبية سكانه هم من الأطفال وكلما طالت مدة بقائهم فيه بشكل تعسفي، ازداد الأمر سوءًا، مما يترك جيلًا جديدًا عرضة للاستغلال ومن دون أي احتمال لعيش طفولة خالية من العنف.
في البداية، وضع عبد الله في مسجد في المخيم، يعيش من إحسان الناس عليه، ولا يعرف شيئًا عن عائلته، ولكنه يتوقع خروجهم من محافظة الحسكة وربما البلاد كلها. خلال الفترة الأولى من بقائه في المخيم كان على أمل اللقاء بعائلته، التي ربما تعتقد بأنه ميت، الأمل الذي تلاشى شيئًا فشيئًا. يقول عبد الله: “في المخيم ستنسى مع الوقت كيف كانت حياتك خارجه، سينحصر تفكيرك في كيفية الحصول على سلة المعونات، والخيمة الجديدة. في أولى سنوات من وصولنا إلى المخيم كان استخدام الجوال والإنترنت ممنوعًا. حتى لو لم يكن الأمر كذلك لم يكن عندي رقم لعائلتي أو أقاربي لأتواصل معهم. أما الآن فأنا أحاول البحث عنهم من خلال الإنترنت عن طريق جيراني في المخيم، ولكن دون جدوى حتى الآن. ربما ماتوا، أمي وإخوتي الثلاثة الصغار، ربما غرقوا أو أحرقتهم قذيفة ما. فقداني لعائلتي أصعب من إعاقتي، العائلة هي الجناح الذي يحلق الإنسان من خلاله في سماوات الحياة الواسعة. كيف لي أن أعيش وحيدًا دون أمي وسخرية إخوتي الصغار المزعجة، توبيخ والدي عندما كنت أستيقظ متأخرًا. الآن لا أحد ينتبه، حتى لو نمت سنة كاملة طالما أنه لا رائحة تفسخ تخرج من جسدي لن يقلق أحد من استلقائي الدائم.”
يتحدث عبد الله عن ذكرياته القديمة، أمه وإخوته والأرض والزرع والمطر، تتدفق الحكايا وتشع العينين بشبح سعادة تسلل من ماضي خفي، وتنتفض الروح. عندما يعود الحديث عن تفاصيل حياته الحالية، يتقطع صوته وتنحني عيناه وجعاً “أعيش الآن أيامي المتشابهة بطريقة مؤلمة. لا يمكنني العمل في الزراعة كما كنت أعمل قبل الحرب لأنه لا يوجد زراعة في هذه الصحراء اللامتناهية حيث نعيش، وبسبب إصابتي بالشلل لا يمكنني أيضًا العمل. لولا إحسان الناس عليّ لمتُّ من الجوع والعطش. صحيح أننا نتلقى مساعدات، ولكن عليك أن تذهب (وأحياناً تركض) إلى المساعدات لا أن تنتظرها حتى تجيء إليك”.

الآن، حدث شيء جديد في حياة عبد الله بعث فيها شيئاً من الحياة مجدداً، “مؤخرًا قررت عائلة أبي عدنان العراقية أن تتكفل بي، فنصبوا خيمة صغيرة لي بجانب خيمتهم، وتكفل الرجل العجوز بحمايتي ورعايتي إلى أن تجدني عائلتي أو أجدها. هذا أجمل شيء حدث لي منذ العام 2019”. يسكت عبد الله مجدداً، ويسرح… أكاد أجزم أنه يتناول فطوره مع عائلته التي تتحلق حول طاولة صغيرة فيما رائحة المطر والعشب تتسلل من النافذة.