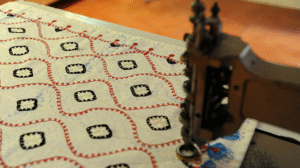شيماء الشريف، منصة إرادة
دخلنا الحي أنا وزوجتي لنرى أقسى مشهد قد تراه عينان، أشلاء ودماء، رجل يمشي وعيناه مفقوعتان ووجه غارق بالدّم، نصف جسد يزحف هنا، وربع جسد ممدد هناك، دخان وغبار يملأ المساحة الممتدة بين الأرض والسّماء، كانت القذيفة الأولى السبب في ذلك، ولم يكن في الوقت متسع لاستيعاب فكرة أنّ هنالك قذيفة ثانية في طريقها إلينا، فتحت عيني في المستشفى بعد ذلك لأجد نفسي محاطاً بعدد كبير من الأحياء الممزقين، بدأت عيناي بالتنقل بين الأسرّة المتراصة كأعواد الثقاب داخل علبة كبريت ليقع أخيراً بصري على ساقيّ غير الموجودتين، ويدي المعلقة بجانبي إلى أعلى السّرير. بشرى ناديت اسم زوجتي يائساً مع إدراكي العميق بأنّها قد توفيت، لم يخبرني أحد بموتها، بل أنا من أخبرتهم. صوت جاء من أعماقي وأدركت بأنّ القذيفة لم تبتر رجليّ وحسب، بل بترت قلبي عندما قتلت بشرى، ولو أنّ القدر سألني إذا ما كنت أريد أن يعيد إليّ رجلاي أو أن يعيد بشرى لاخترت بقاء زوجتي الفقيدة البريئة.

ديرالزور4/4/2016- حي القصور بجانب سنتر القصور أثناء الحصار الوحشي الّذي فرضته داعش على أحياء مدينة دير الزّور بين عامي 2014 و2018. اسمي أحمد العمري وهذه قصتي:
بعد إصابتي، تمّ نقلي مباشرة إلى القامشلي، جواً بطبيعة الحال بسبب الحصار البري المفروض، نقلت مع بقية النّاس إذا صحّت تسمية أكوام اللحم والدّم المعبأة بأكياس. بعد القامشلي أسعفونا إلى المستشفى الفرنسي في دمشق، كان قد مضى ستة أيام على يوم الفاجعة، عقّم الطبيب جرحي بعد أن طرد جميع الأقارب الّذين كانوا بحجرتي المؤقتّة الّتي سأنتقل منها إلى واحدة أكبر وجماعيّة هذه المرّة، طلب منهم الخروج من غرفتي بحدّة تصل إلى القسوة، لا أعرف سبب تعامله بهذه الطريقة معهم. هل كان غاضباً من جرحي المهمل وغير المعقم ويحملّهم مسؤولية هذا الإهمال، أم أنّه أراد تجنيبي العيش لحظة الألم أمامهم. عندما قام الطبيب بتعقيم جروحي صرخت أعلى صرخة في حياتي. كان صوتي غير بشري، لم أسمع حتّى في أقسى أفلام الرعب صرخة مثلها، توقّعت أنّ جدران المستشفى قد تشققت من ارتفاع صراخي، ألم لا تتمناه لأعدائك.
تابعت علاجي في مستشفى حاميش لمدة شهرين، هناك أصبح لي رفيقين جديدين، طرفين من حديد وبلاستيك سيرافقاني بقيّة حياتي. ثمّ تم تحويلي إلى مشفى تشرين ليوم واحد، عدت بعده إلى حاميش مرّة أخرى. شاهدت مرّة مقطعاً مضحكاً لعجوز تسأله المذيعة الجميلة عن أهم اختراع عرفته البشريّة فأجابها ببساطة بأنّ الفياغرا هي أهم شيء جاد به العقل البشري، الجميع يعتقد بأنّ الرّجل العجوز إمّا يفتقد للعقل أو إلى الذّوق ولكنني أعتقد بأنّ هذا العجوز رجل صادق، فكل إنسان يقدّر قيمة الأشياء حسب احتياجه لها، فلو سألتني المذيعة تلك نفس السؤال لأجبتها بأنّ أهم اختراع هو الطرف الصّناعي. على الرّغم من ثقل وزنه، والشّعور الغريب الّذي تشعر به أوّل بضعة اشهر من استخدامه، إلا أنّه خير سند لإنسان يعاني من بترٍ في أطرافه.، أنا الآن لا ينقصني أيّ شيء ولا أختلف عن أي إنسان آخر سليم، خصوصاً بأنني تعرضت للحادث بسن متقدم كان عمري حينها 45 عاماً، فلم أعان من الجانب النّفسي كثيراً، فأنا متزوج وعندي أطفال واستمتعت بأيام الشباب على أكمل وجه، على خلاف زميلي في المستشفى الفرنسي والّذي بتر طرفاه العلويان وكان شاباً في العشرينات من عمره، قال لي ذات مرّة ليتني متّ ولم ينقذني أحد، كيف سأتزوج؟ من ستقبل بي؟

قال لي مرة ليتنا أنا وأنت نصل إلى اتفاق نصبح لعبة puzzle إمّا أن أعطيك رجليّ، وإما أن تعطيني يديك، وبهذا يعيش أحدنا كامل ويموت الآخر، ولكنّ الممرضة سمعته، وقالت له بأن المتبرع لن يموت ففي الغرفة الّتي إلى جانبنا يوجد بالفعل رجل فقد جميع أطرافه، وهو على قيد الحياة وبصحة جيدة، ويثرثر أقل منكما، ثمّ ابتسمت ابتسامة معذّبة وغادرت.
بعد عدّة أيام كان عليّ أن أخرج من المستشفى، فالجرحى الجدد يتوافدون إلى المستشفى من مدن أُخرى كما يتوافد النمل إلى حبّة السّكر، ولأنّ مدينتي دير الزّور لاتزال ترزح تحت الحصار والجوع ولأنني بحاجة لاستكمال العلاج والتدريب على الأطراف الصناعيّة بقيت في دمشق إلى أن تمّ تحرير المدينة وكسر الحصار المفروض عليها من قبل داعش عام 2018. خلال العامين اللذين بقيتهما في دمشق، عمل ابني طه، وابنتاي لين ونجود في معامل الألبسة للإنفاق على البيت وعلى علاجي مع أنّه كان مجانياً على نفقة الدّولة إلّا انّ المصاريف الثانوية مثل إيجار المنزل والمواصلات والطّعام والشراب والكهرباء والتدفئة كانت سيوفاً تضرب خاصرة الأولاد وتفوق قدرتهم على الإنفاق، كانت تصدها مساعدات بسيطة من أقارب لنا خارج البلاد.

عدت بعد عامين إلى مدينتي دير الزور. وأعيش الآن مع ابنتي وابني بعد أن تزوجت ابنتي الكبرى. توقف عملي بعد الإصابة بشكل كامل ليس بسبب إصابتي فقط، بل بسبب إصابة مدينتي، فهي جريحة كما أنني جريح. كنت قبل 2011 أعمل في المنتزهات المنتشرة على سرير النّهر، كابتن صالة مرّة، معلم شيشة، أو مساعد شيف، كل موسم وما يغدقه علي، أصبحت معتمداً على الأرض الّتي تحيط بمنزلي فمنطقتنا أقرب للريف، ابنتي الثانية ستتزوج قريباً، وأنا سأبحث عن زوجة أمضي معها ما تبقى من عمري. صحيح بأنّ ذكرى زوجتي لم تمت في قلبي، ولكن الزواج بالنسبة إليّ حاجة ضرورية، بتّ أخشى من الوحدة وأن أكبر ولا أجد من يتناول معي الطّعام، أو ربما لم أستطع أن أكون مخلصاً كفاية لبشرى، حتّى تفكيري في الزّواج يجعلني أشعر بالذنب.
بعد ثماني سنوات على الفاجعة لم يعد لي من مواس سوى نزار قباني وقصيدة بلقيس الّتي رثى فيه زوجته الّتي توفيت في تفجير السفارة العراقيّة في بيروت. كلّما مررت من نفس الحي الذي قتلت فيه بشرى أتذكر قوله :(ها نحن نبحث بين أكوام الضحايا عن نجمة سقطت وعن جسد تناثر كالمرايا). كنت أحبّ هذه القصيدة وأحبّ نزار قبل حتّى أن تبدأ الحرب في بلادي، ولكنني وبعد سنوات الحرب والجوع والقذارة، أدركت بأنّ نزار جمّل الحرب كثيرا في قصيدته.
بعد كلّ ما حدث معي عرفت بأنّك عندما تكون في بلاد الحرب تتحول إلى مجرد صرصور يركض على أرضية المطبخ وممكن أن يتم سحقك بالحذاء دون أيّ شعور بالذنب، إلّا أنّ الصرصور غالباً سيموت مباشرة، ولن يمضي سنوات حياته الباقية، مع إعاقة جسديّة أو نفسيّة، تحت نفس الحذاء الّذي دهسه.