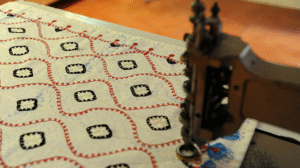شيماء الشريف، منصة إرادة
عشرون يوماً… سبعة عشر يوماً.. ستة أيام على سقوط النظام، أعد الأيام كمن يتحقق من عدد أصابع يده بعد انفجار… ثلاثة عشر عاماً من الانتظار احتضنتها ذاكرتي بعيداً عن كل محاولات المحي والتغييب كما هوية جيل كامل خبأناها عن الجميع. وأخيراً لم نعد جيل الحرب، أصبحنا جيل الحرية. أمشي في شوارع مدينتي، تخبرني أبنيتها المهدمة عن حكاية شعب “عمل عملته وهرب”. أقرأ على الفيس بوك تصريحاً للممثل سامر المصري يقول: “بدهم خبز، بدهم مي، بدهم كهربا، بدهم مازوت وهنن صار لهم 54 بالروح بالدم… إلخ”. لا أعرف كيف أحببنا هكذا مشاهير، وهل يا سامر كنا قبل 2011 بدون كهربا وبدون ماء وبدون مازوت؟ وهل ثورتنا ثورة جياع أم أنها ثورة حرية؟ أنتقل من منشور إلى آخر، الخطاب السائد هو: “فوق ما حررناكن كمان بدكن علمانية”. عبارة “بدكن علمانية” تذكرني بعبارة “بدكن حرية” التي رددها زبانية النظام السابق، وكأن الشعب كان في رحلة سياحية على جزيرة بعيدة بينما كانوا يحررونه، ولم يدفع كل سوري بسيط ثمن الحرية ثلاثة عشر عاماً من عمره وعمر أولاده قضاها إما في المعتقل أو في الخيام أو في بيته يرتجف من الخوف والبرد، ولم يمت صحفيون وكتاب وعلماء ومدنيون عزل ودفعوا أرواحهم ثمناً لها.

أتذكر الأيام الأولى لسقوط الأسد، أسترجع ذكرياتي خلال سنوات الثورة، قضيت نصف عمري في الثورة. كان السقوط متوقعاً في ظل الأخبار المتسارعة التي كنا نسمعها، ولكن كلمتي “سقط النظام” سهلة على الأذن صعبة على الاستيعاب. تذكرت عادل إمام عندما يقول: “الرئيس، ربنا يطول عمره مات؟!”. كنت في مدينة الحسكة حينها لسوء الحظ، لم يحتفل الناس هناك بسبب سيطرة قسد سلفاً على معظم المدينة ودخولها إلى المربع الأمني الذي انسحب منه بقايا النظام. شغلت الشاشة على قناتي الدنيا والفضائية السورية، كانتا تبثان وثائقياً عن قلعة حلب استمر البث لمدة ثلاث ساعات قبل أن ينقطع بشكل كامل.
شعوري بالضبط مثل شعور امرأة كانت تمشي بكل طمأنينة في وسط شارع دامس الظلام، وبعد تجاوزها الشارع لمع النور لتعرف أن الطريق التي سلكتها بكل سذاجة لم تكن سوى خط على جانبيه حفرتان داخل كل منهما وحوش، أفاع، ومسوخ. سيخلع الخوف قلبها بقدر ما كانت طمأنينتها مصدرها جهلها بما عبرت من خلاله.
مع كل صورة لمعتقل تحرر يقرفص ويحتضن نفسه التي خذلناها كلنا، يحاول المحاور أن يقتلع منه كلمة أو حرفاً ويعجز لأن السجان اجتث اللغة واستأصل منه الروح التي تشعر وتعبّر. أتخيل نفسي مكانه وأرى وجهي بين كتفيه الذابلتين كجذع شجرة ميتة ومحترقة. كم كنت ساذجة عندما كنت أعبر الطريق جيئة وذهابًا بين مدينتي الحسكة حيث نزحت منذ عام 2012 ودير الزور حيث أدرس الماجستير في الهندسة الزراعية. أسلم هويتي للعنصر على حاجز السلامة عند مدخل دير الزور، تتأملها عيناه الخبيثتان. لا أعرف كيف نجوت ولم أذهب كما ذهبوا هم.
بدأت أتذكر عندما تشاجرت مع طالبة في نفس كليتي (الهندسة الزراعية) أثناء الامتحان. كنا نجلس بالقرب من بعض والمراقب يعطيها أوراقاً مكتوبة عليها الإجابات وسحب ورقة زميل لي كنت قد حاولت أن أغش منه. ولو كان سحب مني ورقتي لما غضبت، ولكنني شعرت بأنني ألحقت أذى بذلك الشاب. ما كان مني إلا أن اعترضت على تنقيله لها. قالت لي: “إنتِ ما تعرفين مع مين عم تحكين أنا عضو قيادة الفرع” فأجبتها بكل بلاهة وكأنني مواطن أوروبي يحميه القانون ويصون كرامته وحياته الدستور. قلت لها بلا تفكير في العواقب: “شي بهوي”.
بعدها نظر إليّ الطلاب بعين الشفقة وقالوا لي: “إنتِ شلون تعلقي مع هي أبوها بالأمن وهي مدعومة بالحزب”. مر عليّ اليوم طويلًا، وفي اليوم التالي وقفت أنتظرها طويلًا، وما إن لمحتها حتى اعتذرت منها اعتذار المشنوق من حبل مشنقته. لا أعرف لماذا لم يشحطني الفرع حيث يعمل أبوها، ربما تداركت نفسي بالاعتذار قبل أن تجتمع معه. حصلت هي لاحقًا على كرسي في مجلس الشعب، والآن أنا أشمت بها وبقيادة الفرع، وبفرع أبيها وبمجلس الشعب.
زميلة ثالثة في جامعة الفرات، ولكن كانت في كلية هندسة البتروكيميا كنا قد تقاربنا من بعض قليلًا، القرب الذي جعلني على علم بأنها على علاقات مريبة بعناصر من الميليشيات الموالية للنظام، وبأنها تهرب الحشيش بين دير الزور ودمشق لصالح أخيها. عندما اخترت الانسحاب من صداقتنا التي لم تبدأ استشاطت غضبًا، خصوصًا بعد أن قلت لها بأنني كنت متحاملة على والدتي بسبب قسوتها وجفاف ينابيع عطفها، ولكنني الآن أرغب بتقبيل أقدامها على الأقل لأنها طاهرة. يبدو أنني استخففت بذكائها ولم أعتقد بأنها ستلتقط رسالتي وتفهم مغزاها بهذه السرعة. المهم أنها لم تترك شتيمة لم تنعتني بها، وهددتني بأنه لو تبقى يوم واحد من عمرها لن تتركني فيه أنعم بحياتي. عشت عامًا كاملًا من الخوف قبل أن أتأكد أنها نسيتني، وهذه المرة أيضًا نجوت. صحيح أنها نسيتني على ما يبدو، ولكنني لم أنسها… أحياناً أتعاطف معها.
صديقتي كانت فتاة لم تتجاوز الثالثة والعشرين، وجدت نفسها فجأة نازحة هي وعائلتها في منطقة السيدة زينب في دمشق. الأب يقيم في مكان لا أعرفه، والأخ الأكبر مدمن، ويبدو أنه من ورطها في تهريب المواد الممنوعة. الأم كما لاحظت ترى كل شيء وتعتبر أن الوضع طبيعي طالما أن كل شيء يجري تحت جنح الليل. لم يكن الفساد فقط أحد أدوات هذا النظام، بل الإفساد أيضاً، أراد تلويثنا جميعنا، لكن في النهاية، انتصر الخير فينا. من أجل صديقتي هذه ومئات الآلاف على امتداد سوريا اللواتي دفعن فاتورة غياب القانون، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإفساد الممنهج من نقائهن ومستقبلهن وذواتهن. يجب أن نتابع نضالنا حتى يكون لكل واحدة منا جامعة تدرس فيها، وبيت دافئ يأويها، وقانون عادل يحميها، فلا تضطر أن تعيش في ظل أب أو أخ أو زوج يذلها أو يعرضها لمكروه.

في اليوم الأول لسقوط النظام، لا أعرف لماذا كان والدي أول شخص يخطر على بالي. فرحت كثيرًا أن الله أعطاه عمرًا ليشهد سقوط الأسد. اتصلت به وقلت له على سبيل المزاح السمج إنه رسميًا يشهد حقبة ثالثة بعد حقبتي الاستقلال والبعث، في تلميح غير مهذب عن طول عمره. ربما من أعراض الصدمة أن نكون أقل تهذيبًا.
خلال سنوات الثورة التي كنا نسميها من خوفنا سنوات الأزمة أو سنوات الحرب، كنت أحزن كلما نظرت في عيون أطفال شقيقتي. أخاف عليهم كثيرًا، أرغب بإعادتهم إلى رحم أختي. كنت أحزن على والدي الطاعنين في السن، خصوصًا والدي الذي أصبح لا يستطيع أن يغادر فراشه. يعتصر قلبي كلما تذكرته يمشي متكئًا على عكازه ويروح إلى السوق. كنت حينها أراه هزيلًا وضعيفًا، ولكن في آخر خمس سنوات، أصبح يصعب عليه أن يصل إلى الحمام دون الوقوف عدة مرات للاستراحة. أصبحت أشتاق لتلك الأيام التي أراه يمشي خارج البيت حتى وهو على عكازه. أحقد كثيرًا على بشار الأسد ونظامه، وأعتقد بأن والدي تراجعت صحته بسرعة بسبب الأسقف التي بناها فوق صدورنا، والظروف التي قادنا إليها من خوف وهلع ونزوح لعدة مرات. كان كل هذا كثيرًا على آبائنا ليحتملوه دون أن تنهار قواهم وتضعف.
“الأمل بالعمل”، خذوا الحكمة من أفواه المجانين. اليوم فقط يمكننا أن نؤمن بهذه الحكمة بعد أن سقط قائلها. أشعر برغبة كبيرة في العمل، يسعد قلبي كلما تخيلت أن الطبقة الوسطى التي انهارت خلال سنوات حكم الطاغية ستتعافى. أحب الطبقة الوسطى كثيرًا، أقدسها لأنها الوحيدة التي تبني الأوطان. أولادها في المدارس، والجامعات، والمعامل، والمصانع. أحبها بأثاثها الأنيق، طعامها المتنوع البسيط، بمكدوسها، زيتونها، قطنها، صوفها وجدائل بناتها.
وأيضاً، أحبّ رجلاً من الطبقة الفقيرة، رجلاً شجاعاً أو مجنوناً لا أعرفه كثيراً ولكنني أتذكر حادثة طريفة له: في العام 2012 عندما كان زبانية بشار في أوج طغيانهم كان بطلي هذا يقود طنبراً (عربة خضار يقودها بغل) في حي سينما فؤاد، بالضبط أمام مبنى الشّرطة العسكريّة، وعندما وقف البغل نهره بأعلى صوته أمام العسكر وقال: (دييي أبو ركيبة) ضحك جميع من في الشّارع بينما تسلل هذا المجنون الشّجاع من الشّارع بسرعة بعد أن استوعب خطورة ما نطق به، ولكنّه على أيّة حال مصطلح لا يفهمه سوى الديريين، ولحسن الحظ لم يكن بين العابرين خائن أو واشٍ.